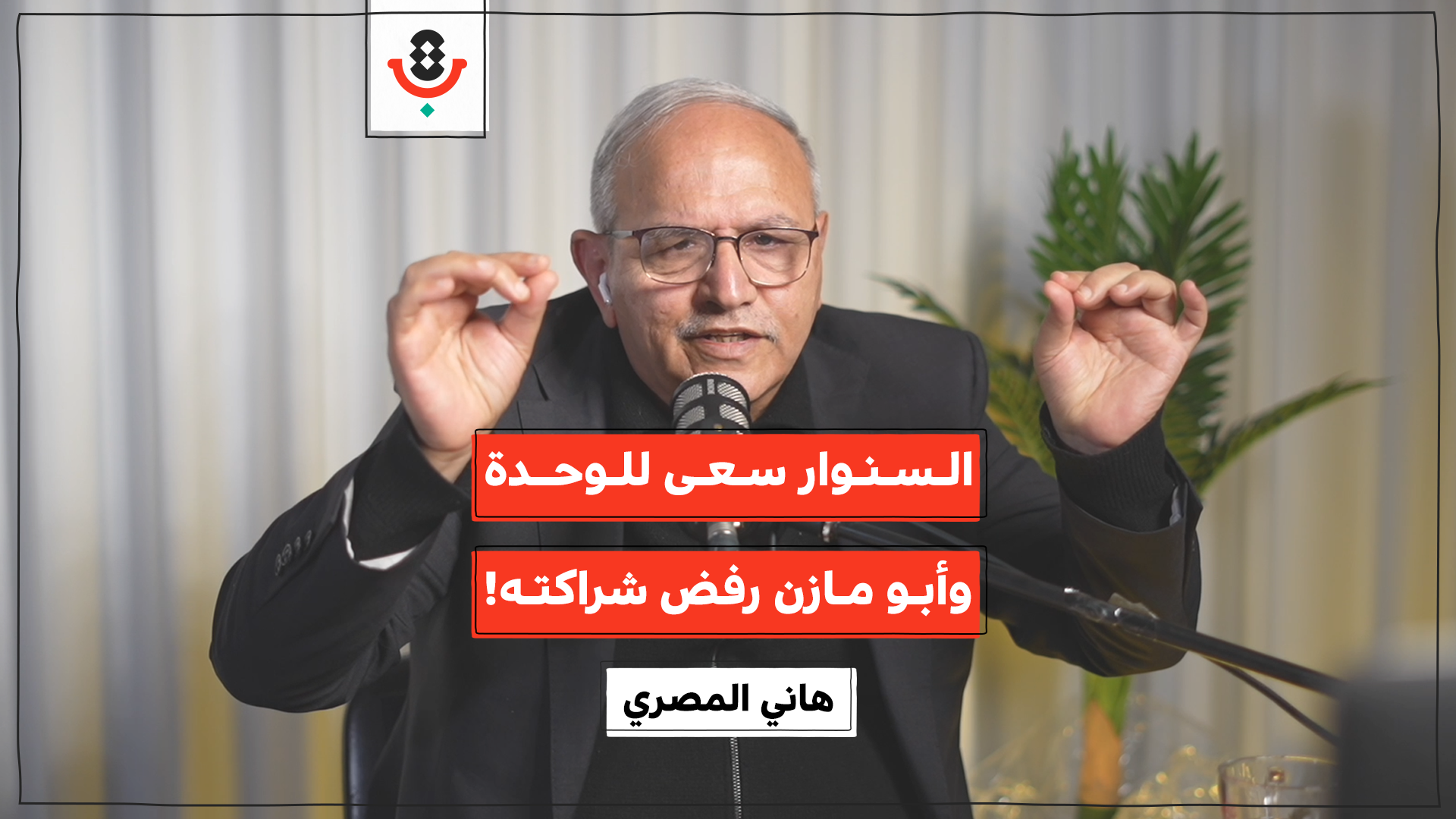في زمن التفكك والعدوان المتكرر، يزداد سؤال الهوية الفلسطينية إلحاحًا:
هل ما زلنا نشكّل شعبًا موحّدًا، أم تحوّلنا إلى جماعات متفرقة بهويات مناطقية؟ وهل يُمكن لهوية نشأت من نكبة، أن تصمد أمام نكبات متكرّرة؟
في هذه الحلقة من بودكاست تقارب، نحاور الباحث والمؤرخ، سليم تماري، في محاولة لاستعادة الخط الزمني لبناء الهوية الفلسطينية، وفهم كيف تشكّلت، ولماذا تتشظى، وما الذي يمكن إنقاذه منها.
🔹 ماذا كنا قبل النكبة؟
🔹 متى وُلدت الهوية الفلسطينية فعليًا؟
🔹 كيف أثّر الشتات والانقسام السياسي على الشعور بالانتماء؟
🔹 هل نحن شعب تشكّل من كارثة، أم ذاكرة جماعية متينة؟
🔹 لماذا زاد الهوس بالتراث الشعبي في العقود الأخيرة؟
🔹 ما الذي فعلته سايكس–بيكو ووعد بلفور بالتصوّر الذاتي لفلسطين؟
🔹 هل العودة للهويات المناطقية اليوم هي مقاومة؟ أم استسلام؟
🔻 نناقش أيضًا:
– الفجوة بين الهوية الثقافية والسياسية
– أثر الحرب والشتات على تصوّر الفلسطيني لنفسه
– من "سوريا الجنوبية" إلى فلسطين… كيف تغيّر الاسم والرؤية؟
– السلطة، أوسلو، مؤتمر أريحا… محطات ساهمت في تفكيك الجماعة الوطنية
– ولماذا لا تزال فكرة "الشعب الفلسطيني" حيّة رغم كل شيء؟
🧠 الضيف: سليم تماري، باحث رئيسي في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أستاذ متقاعد من قسم علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، وأحد أبرز منظّري الهوية والسوسيولوجيا الفلسطينية.
🎙️ المحاور: أحمد البيقاوي
شكرًا لصديقات تقارب:
أسماء المزيّن، على تيسير الحلقة وتنسيق التواصل مع الضيف
وللزميلة عُلا وتد على حضور التسجيل ومشاركتها لأفكار من الحلقة تمت معالجتها.
نرفق لكم في الأسفل نص تفريغ الحلقة الصوتية بالكامل:
سليم تماري: [00:00:00.05]
أنا حين ذهبت على الجامعة، كنت أعرّف نفسي "مواطن أردني".
أحمد البيقاوي: [00:00:04.55]
لو لم تحدث النكبة. نحن ماذا نكون؟
سليم تماري: [00:00:06.47]
لا تنس أنه بفترة الانتداب (البريطاني) ما كان في محاولة محو الهوية الفلسطينية.
سليم تماري: [00:00:11.63]
الناس ينسون انّ الكفاح المسلح لعب دورًا كبيرًا في تعزيز الهوية الفلسطينية المستقلة عن الوصاية العربيّة.
أحمد البيقاوي: [00:00:18.35]
ماذا كان يأتيك من انطباع عني لو جئت ورأيت هذه الرموز في البيت؟
سليم تماري: [00:00:24.11]
أراك كأحد مصادر هوس الشتات.
أحمد البيقاوي: [00:00:29.39]
ههههه
سليم تماري: [00:00:29.39]
المهمّ جدًا في تاريخنا طبعًا.
أحمد البيقاوي: [00:00:30.80]
متى ينفع أن نقول بدأت مساعي توحيد الهوية الفلسطينية؟
سليم تماري: [00:00:34.79]
الذي صار بعد ال 1948. طبعًا إنّه قُمعت الهوية الفلسطينية ليس فقط في إسرائيل؛ قمعت في العالم العربي أيضًا، لأنهم صاروا يخافوا منها.
سليم تماري: [00:00:43.73]
ببداية القرن كانت الهوية محليّة جدًا وهذ لها معالمها. إنّه الواحد يعرّف حاله إنه لداوي (من اللد) يافاوي (من يافا) غزاوي (من غزة). وفي صراع داخل غزة بين اللاجئين.
سليم تماري: [00:00:58.68]
الهزيمة دائمًا تؤدي بالناس أن يرجعوا لقوقعة الرؤية المحليّة، ومرّات العائلية العشائرية.
سليم تماري: [00:01:09.06]
مرحبًا. السلام عليكم. أنا اسمي سليم تماري، باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأستاذ متقاعد من جامعة بيرزيت في قسم علم الاجتماع. أحرر؛ حتى فترة قريبة جدًا، كنت أحرِّر مجلة فصليّات القدس التي تصدر عن مؤسسة الدراسات، والقسم الانجليزي منها بعنوان Jerusalem Quarterly (حوليّات القدس) يعالج قضايا في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني ومصير مدينة القدس ومستقبلها.
سليم تماري: [00:01:54.33]
بالنسبة للحوار اللي صار مع الأخ احمد، الحقيقة كثير كان حوار مشوّق بالنسبة لي، لأنه جعلني أفكر بقضايا إشكاليّة، ليس دائمًا أفكر فيها، خصوصا على ضوء حرب الإبادة التي نعيشها حاليًا في غزة، ومحاولة المثقف الفلسطيني أن يعيد النظر بكثير من الصيغ والمقدّسات والإشكاليات التي تعالج وضع الفلسطيني ومستقبله.
سليم تماري: [00:02:29.52]
والأخ أحمد سألني أسئلة مثيرة جدًا، بعضها استفزازي وبعضها مهدّئ. لكن بكل الاحوال جعلنا نفكّر بقضايا مصيريّة تواجهنا حاليًا. وين رايحين؟ وين كنا؟ وين رايحين؟ وهذه كلّها يجب أن نفكر فيها بنوع من الأريحيّة، لأنه غلط دائمًا أن ننزل لالتزامات عقائدية التي الوضع الراهن يصرّ علينا أن نعيد النظر فيها. ونميّز بين المبادئ التي يجب أن نحافظ عليها، والمرونة الفكرية التي يجب أن نتجاوز فيها العقائد اللي كنّا نرتكز عليها في السابق.
أحمد البيقاوي: [00:03:46.20]
مرحبًا وأهلًا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من "بودكاست تقارب". معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز الدكتور سليم تماري. أنهينا الحوار قبل قليل، وسترونه أمامكم. حوار طويل. لكن في أسئلة كنت مُحمّل بها، من سنين طويلة، تتعلق بالهوية الفلسطينية بعيدًا عن الرمزيات، بعيدًا عن اختزالها بحدث النكبة، بعيدًا عن اختزالها بحدث ممكن نحن عايشناه. وبعيدًا حتى عن السؤال الذي أنا في كل حلقة من الحلقات كنت أطرحه بسياق ما هو الحدث المؤسس لهويتك الفلسطينية؟
أحمد البيقاوي: [00:04:22.79]
جرّبنا أن نرى هذه الهويّة الفلسطينيّة الجامعة ككل. كيف فعليًا، بماذا مرّت بتحديات؟ المحطات التي جمعتنا؟ متى تفرّقنا وأين تفككت؟ أو تفتتنا بمكان ما، وصولًا للمحل ما قبل أو ابتداء وانطلاقًا من المحل ما قبل النكبة، وصولًا للأيام الصعبة التي نعيشها كمان، ومحاوله لاستقراء المستقبل كيف سيكون بناء على تفاصيل سنين طويلة وتاريخ عشناه.
أحمد البيقاوي: [00:04:50.33]
قبل ان ابدأ أود أن أشكركم على اشتراككم في قناة اليوتيوب، قنوات البودكاست ومشاركة هذه الحلقة وهذا الحوار مع كل شخص ممكن يكون مهتم فيه. شكرًا لكم على دعمكم واستمراركم في دعم محتوى "تقارب" من خلال الرابط الموجود في الوصف.
أحمد البيقاوي: [00:05:11.13]
وشكرًا دائمًا لكل من يشارك ويساهم في إعداد وتنفيذ حلقات "تقارب" ومشاركتكم أفكاركم؛ مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة والضيوف. وبهكذا نبدأ:
أحمد البيقاوي: [00:05:26.10]
خلاص خلصتوا منّا جاهزين؟ والله جنناها لأسماء!
أحمد البيقاوي: [00:05:29.10]
أهلًا وسهلًا فيك، ويعطيك ألف عافية. مبسوط إنّك في اسطنبول؟ تُحبّها؟
سليم تماري: [00:05:36.15]
كثير أحبّها اسطنبول، وصار لي فترة غايب عنها، وسُعدت اني جئت هنا، وأشكرك على الاستضافة.
أحمد البيقاوي: [00:05:43.86]
100 أهلا وسهلا. إذا بدك تحكي شيء خارج نطاق الاشياء التي نعرفها سياسيًا عن اسطنبول، او عفوًا على مستوى السياحة، وعلى مستوى سياسة، على اسطنبول. حين تأتي إلى هنا -بكل مسارك الذي اشتغلته على مستوى التاريخ والتوثيق- في شعور ما او في فكرة ما تراها انت. ونحن لا نراها في البلد هه، تجعلك تحبّها أكثر.
سليم تماري: [00:06:10.22]
لأنه أنا من فترة حوالي 7-8 سنين بدأت اهتم بالمذكرات التي تعالج نهاية الفترة العثمانية، وبالتالي كان عندي اهتمام شديد بالادب العثماني وعلاقة اسطنبول مع بلاد الشام، ومع متصرفيّة القدس الشريف. وكان في مجموعة هائلة من الوثائق الموجودة في الارشيف العثماني بأنقرة واسطنبول، فيعني صارت مثل محجّ -اسطنبول- لكثير من المؤرخين والجغرافيين والناشطين بالعلوم الاجتماعية العرب، أن يأتوا ويستفيدوا من هذا الانقطاع الذي صار بعد الحرب العالمية الأولى والذي كانت فيها اسطنبول تشكّل العاصمة.
أحمد البيقاوي: [00:07:12.86]
في "تقارب" عادة نترك الضيف يعرّف نفسه كما يحب، يعني وبمسارك أنت فعليًا كان في أكثر من حدا اجتهد وعرفك. كتب لك نبذة، ندخل على المواقع تكون أنت مشارك نبذة ما، لأنهم بالعادة يقولون لك نريد 100 كلمة أو 150 ولا 50 كلمة ولا كذا. فإذا بدي أتعرّف عليك كما تحب أن تُعرّف عن نفسك اليوم؟ بعيدًا عن التعريفات الرسمية فقط.
سليم تماري: [00:07:43.19]
انا أعرّف حالي عالم اجتماع وليس مؤرخ. لكن صرت أهتم بالتاريخ، وصرت يعني تقريبًا أعرّف نفسي كأني عالم اجتماع تاريخي، في علم اجتماع التاريخ. انا باحث في "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" في رام الله، منذ 20 سنة أشتغل معهم، وبنفس الوقت كنت استاذ والآن أستاذ متقاعد في جامعة بيرزيت، في قسم علم الاجتماع.
أحمد البيقاوي: [00:08:16.71]
أنا أحب التفاصيل.
سليم تماري: [00:08:18.96]
ماذا تريد من يوم ولدت للآن؟
أحمد البيقاوي: [00:08:20.67]
والله أحب.
سليم تماري: [00:08:22.95]
ماذا تُحب أن تعطينا فعليًا أو تشاركني تفاصيل اعطني.
سليم تماري: [00:08:27.45]
طيب طريق سريع جدًا. انا مولود بمدينه يافا مولود سنة 45 قبل النكبة يعني. كان عمري سنتين ونص في الهجرة. هاجرنا مع عائلتي كطفل. على لبنان ومكثنا اربع - خمس سنين بلبنان ثم عدنا الى فلسطين بداية الخمسينات. فمن بداية الخمسينات لليوم وانا ساكن بالضفة الغربية في مدينة رام الله. ومررت طبعًا نهاية الانتداب، مجيء الحكم الأردني على الضفة الغربيّة وبعدها الاحتلال الإسرائيلي ومجيء السلطة سنة 1993 - 1994 على رام الله. يعني مرت علينا اربع حقب سياسية، وكثير من الحروب الدامية في حياتنا ولازلنا في هذا المخاض.
سليم تماري: [00:09:32.69]
درست في جامعة بيرزيت ثم انتقلت إلى امريكا بالستينات، وحصلت على الماجستير الأولى، والماجستير الثانية. وبعدين كملت دراستي للدكتوراه في جامعة مانشستر في بريطانيا. ثم رجعت لبيرزيت وأكملت، يعني استمريت في التدريس في جامعة بيرزيت حتى تقاعدت قبل كم سنة.
أحمد البيقاوي: [00:10:03.15]
وكيف لا تحب أن ستم تعريفك أو وصفك؟
سليم تماري: [00:10:07.17]
كيف لا أحب أن يتم تعريفي؟ لم أفكر في الموضوع. إذا أنت تحب أن تقترح أشياء؟
أحمد البيقاوي: [00:10:14.46]
لا أنا أفكر أنك تعرضت لمواقف كثيرة بحياتك. او في تعريفات لا تفضلها او اوصاف لا تفضلها.
سليم تماري: [00:10:21.27]
تعرف هويتنا تغيرت كثير لأننا ولدنا في بلد اسمه فلسطين. بعدين تجزأت فلسطين الى ثلاث اقسام بقطاع غزة و"إسرائيل" صارت الدولة اللي استولت على مناطق التقسيم. وما بعد التقسيم، ونحن انتهينا في الضفة الغربية، ففترة كنت في لبنان. لاجئ لبناني في فلسطين. بعدين جئنا على الأردن وصرنا نعرّف حالنا كأردنيين. انا حين ذهبت على الجامعة كنت أعرّف نفسي مواطن أردني، لأنه كنا مواطنين اردنيين. انتهت فلسطين يعني بالنسبة لنا. ثم عادت وبعثت بنهاية الستينات بعد الاحتلال الاسرائيلي وهذا أعادنا. طبعًا نحن دائما نعرف اننا فلسطينيين لكن رجعنا لهويتنا الفلسطينيّة بقوّة، مع بروز منظمة التحرير وفصائل المقاومة. وصار في نوع من ال... يعني تعززنا بإعادة هويتنا لنا التي اختفت لحوالي عشرين سنة.
أحمد البيقاوي: [00:11:39.48]
بتقارب أنا الآن يعني هذه يمكن تكون الحلقة 162 او 163 لكن على مدار هذه الفترات كنت مع كل ضيف أجرّب أن أبحث على الحدث المؤسس او هكذا ينفع أن اسميه. يعني الحدث الذي جعل العلاقة مع فلسطين تتجاوز العلاقة العاطفية او الرومانسيّة او الرمزيات فقط. فألاقي في مسار كل حدا فلسطيني او غير فلسطيني، في حدث موجود صار بنشأته عمل هذا الفارق، جعله أكثر اشتباكًا مع فلسطين أو أكثر خصومةً وعداءً للاحتلال وفكرته. إذا رجعنا لأول صور في نشأتك فعليًا التي عملت لك هذا المشهد. ماذا تستحضر منها؟
سليم تماري: [00:12:26.49]
أتذكر أنا كنت أجمع طوابع ولقيت اوراق لأهلي فيها ختم كان من دائرة الهجرة اللبنانية يقولون إنهم دخلوا في اجازة للبنان. هذا الحكي كان في نيسان/ ابريل 1948. فذُهلت. كيف إنّه هاجرنا وهُجِّرنا من وطننا. وهم طبعًا كانوا يظنون أنهم ذاهبون لفترة قصيرة فخُتم جوازهم انهم ذهبوا سياحة على لبنان. إجازة. فالإجازة. طبعًا استمرّت كل حياتنا. وقتها طُبعت في ذهني كم الحرب التي نعتبرها كانت الفاصل التاريخي بحياة الشعب الفلسطيني وهي حرب النكبة. بيّنت بشكل مبتذل جدًا إنه رايحين كإجازة واختفت هويتهم، وصاروا لاجئين في لبنان ثم رجعوا على الضفة الغربية كمواطنين أردنيين. يعني لمعت في ذهني للحظة، قديش في مفارقة بهذا التاريخ؟ كيف قديش في ابتذال لتجربة النكبة التي خُتمت سياحة أو إجازة بلبنان؟
أحمد البيقاوي: [00:14:03.96]
قديش كان عمرك وقتها؟
سليم تماري: [00:14:06.24]
كان عمري سنتين ونصف حين ذهبنا، لكن أنا الحادث الذي أحكي لك عنه، بعد سنين كنت كبير يعني، كنت بآخر سنوات المراهقة، انتبهت. طبعًا اهلنا كانوا عندهم نوع من الخجل او ليس خجل، نوع من عقدة الذنب إنّه كيف فقدوا فلسطين. ما كانوا يحكوا كثيرًا عن النكبة. أنت إذا تنتبه. معظم الفلسطينين اللي لجأوا على لبنان وسوريا والاردن ما كانوا يحكوا لابنائهم عن تجربة النكبة. كان في نوع من النسيان المتعمّد. وما بدأت هذه التجربة ترجع إلا بعد الاحتلال. يعني حين صار في نكبة ثانية (حرب حزيران 67) بدأوا الناس في 20 سنة أو 19 سنة بدأوا الناس يستعيدوا ما حدث، ووقتها فقط بالسبعينات بدأوا يحكون عن.. يعني مثلا انا اشتغلت مع "جمعية انعاش الأسرة" في البيرة. كان عندهم مجلة ساهمت في انشائها اسمها "التراث والمجتمع" لأول مرّة ظهر اهتمام باستعادة ما حدث في النكبة، عن طريق المذكرات؛ صار في اهتمام بنشر المذكرات فقط في تلك الفترة، لأنه قبلها كثير قليل ناس مثل سامي هداوي، وقسطنطين زريق الذين كتبوا عن النكبه بشيء من التأريخ الموضوعي. لكن قبلهم ما كان في حدا يحكي عنها. كانت تعتبر حدث درامي أنهى وجودنا في فلسطين.
أحمد البيقاوي: [00:16:07.85]
حين يُحكي عن النكبة. يعني. أمس حين بدأنا نحكي في الموضوع. أوّل شيء قلت لك اياه إنّه النكبة عادة تُحكى كحدث مؤسس للهويّة الفلسطينيّة أو كردة فعل. وفي أذهان أناس كثيرة، هي مؤرّخة بتاريخ يوم او يومين او ثلاثة. يعني ليست مجموعة أحداث فعليًا. لأنه تعرف نحن نحتفل فيها أو نقف على ذكراها أو نحيي ذكراها كل سنة. إذا سأرجع إلى ما قبل النكبة. إذا ستحكي لنا أصلًا على هويتنا. من أين نشأت؟ أو ماذا كنّا قبل النكبة. من أين تبدأ؟
سليم تماري: [00:16:49.62]
أبدأ بالحرب العظمى الأولى. بالنسبة لي كمؤرّخ اجتماعي. نهاية العهد العثماني كان لحظة فارقة بتاريخ كل شعوب المشرق العربي، بما فيها سوريا ولبنان والعراق وشرق الاردن. لأنه وقتها انتهت حقبة كان عمرها 450 سنة تقريبًا بالحكم العثماني. الذي يسمونه الحكم التركي -إجحافًا- هو كان حكم متعدد القوميات وكل العرب والأكراد والأرمن والشعوب الأخرى بالبلقان كانوا ممثلين في الحكم. الذي صار انّه في تلك الفترة كان تحالف مدمّر من قبل الدولة العثمانية. اختاروا أن يتحالفوا مع المانيا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا، ضد الحلفاء يعني. وطبعًا صارت معارك دامية فيها بأربع أجزاء: المشرق (منطقة جناق قلعة في الدردنيل بمنطقة اسطنبول). ومنطقة ارض الروم بالشمال الشرقي. وكوت العمارة بجنوب العراق. وما يسمى بجبهة فلسطين (غزة وبئر السبع) فحاربوا على كل الجبهات. وكان المجندون العرب من بلادنا يرسلون إلى هذه الأصقاع، لأنه كانت في سياسة موجّهة من قبل الدولة العثمانية. أن لا يبعثون المجندين لمناطق قريبة على بلادهم خوفا من أن يهربوا. فالأتراك كانوا يقاتلوا في بلادنا. والعرب كان يقاتلوا في معركة "غاليبولي" المشهورة مثلًا التي خاضها مصطفى كمال وبرهن على قدراته العسكرية. كان معظم المجندين سوريين، والسوريون كانوا أهل فلسطين ولبنان. والجمهورية السورية. كانوا يسموهم سوريين لأن سوريا كانت البلاد. فهذه الحرب عملت شغلتين. اول شيء: أبرزت النعرات القومية داخل الدولة العثمانية. ومن ناحية ثانية، فجّرت وعي اقليمي. نحن نسميه قومي لكن هو اقليمي في تلك الفترة التي برزت فيها الهوية السورية والفلسطينية واللبنانية بشكل واضح. وطبعًا في مؤرخين يدّعون أنه كان دائمًا في صراعات دامية داخل الدولة العثمانية بين هذه المجموعات الاثنية، لكن هذا الحكي غير صحيح يعني.
سليم تماري: [00:19:54.01]
طبعًا كان فيه حروب طائفية تصير لكن كانت استثناء عن القاعدة. القاعدة كانت إنه كان في عندك حكم لا مركزي. مركزه الاستانة في اسطنبول. لكن الشعوب العربية والكردية والآرمنية كان عندها حكم ذاتي واسع المجال. يعني اذا تتطلع على فلسطين، القضاة والحكام الاداريين كلهم كانوا محليين. وكانت اللغة العربية هي التي تستعمل في التدريس. فقط في الحرب صار في تحيّز اسمي لصالح القومية التركية فهذه زادت الحزازات، واللحظة المفصلية كانت حين محمد جمال باشا -آسف- أحمد جمال باشا حاكم سوريا ورئيس الاتحاد والترقي بدأ ثلاث سنوات من الحكم الدكتاتوري في سوريا، وكان مقرّ قيادته في دمشق، حلب، دمشق. بعدها بالقدس كان مركز القيادة في ما يسمى بمستشفى المطلع اليوم "الأوغستا فكتوريا" تعرفه انت؟
أحمد البيقاوي: [00:21:17.36]
آه.
سليم تماري: [00:21:17.36]
فالذي صار إنه كي يحمي الجبهة من العناصر الانفصالية، بدأ تجميع الوطنيين العرب وإعدامهم. فصارت الإعدامات المشهورة بسنتي 1915 -1916 في باب العامود بالقدس. وفي دمشق ساحة المرجة. وأهمّ إعدامات صارت بباحة ساحة الشهداء التي كان اسمها "البرج"، ولليوم يسمونها البرج في بيروت. فهذه فجّرت نقمة كبيرة على الحكم العثماني ما انتهت إلّا بنهاية الحرب وانفصال العرب عن الأتراك. وطبعًا تحالف بين الهاشميين في الحجاز ،والقوميين السوريين بمعنى الوطنيين يعني ليس الحزب القومي في بلاد الشام بما فيها نواب القدس وبيروت وحلب ضد الدولة العثمانية. وبرزت من خلال معاهدة سايكس بيكو. مؤامرة هي ليست مؤامرة، هي كان تخطيط لتقسيم إرث الدولة العثمانية لدويلات، برزت معها العراق وفلسطين وشرق الأردن من ناحية النفوذ البريطاني. وسوريا ولبنان تحت نفوذ الدولة الفرنسية.
أحمد البيقاوي: [00:23:09.02]
في حدث آخر أو في تفصيل آخر قبل النكبة. يجب أن نذكره بسياق كيف كنا نعرّف حالنا أو الظروف التي نشأنا فيها وكانت تخلق لنا تعريفات؟
سليم تماري: [00:23:22.05]
في سياق مهم. برأيي انّ الوطنيين الفلسطينيين حين اكتشفوا، طبعًا "النخبة المثقفة" العربيّة كان قسم كبير منها يعني يراهن على استمرار الدولة العثمانية، وكان في شعور قوي أننا نقاتل الانجليز والفرنسيين لصالح بقائنا ضمن السلطنة العثمانية. فالذي صار مع هزيمة معركة غزة ومعركة القدس والمعارك الأخرى التي صارت، الناس صاروا يقولون خلص، نحنا سنصير جزءًا من دولة أكبر وهي سوريا كموطن للعروبة. لأن دمشق كانت أهم مركز للعروبة. والذي صار انه في تلك الفترة اكتشفوا انّ مصير فلسطين بالاستقلال عن سوريا يعني هيمنة المشروع البريطاني الصهيوني.
أحمد البيقاوي: [00:24:31.94]
نحن هون نحكي عن اي سنين؟
سليم تماري: [00:24:34.04]
عم نحكي عن سنة 1916 - 1917- 1918.
أحمد البيقاوي: [00:24:38.69]
لكن هنا لفتني بتحكي إنه "الوطنيين الفلسطينيين" كانوا يُعرّفون أنفسهم حالهم هكذا في حينها؟ أم الآن باثر رجعي؟
سليم تماري: [00:24:44.18]
لا كانوا الناس يقولوا نحن من فلسطين. يعني فلسطين كانت موقعًا ليس إداريًا، كانت بلادًا مقدسة يقولوا نحن فلسطينيين نحن من فلسطين، وفي جريدة اسمها فلسطين. اول ما سمحت السلطات بحرية النشر سنة 1908 بالثورة الدستورية سمت حالها جريدة فلسطين من يافا هي كانت تصدر عن عيسى العيسى، فكانت تعكس الشعور إنه نحن نحن جزء من هذا البلد الذي لم يكن يعني له حدود اداريّة واضحة، لأنه تحت السلطه العثمانية فلسطين كانت اسم على الخرائط لكن تمتد من صور للعريش. كانوا على الخرائط العثمانية يكتبوا فلسطين ومركزها كانت سنجق القدس الشريف، والقدس الشريف كانت نصف فلسطين. كانت تمتد من يافا شمالًا إلى العريش. ويعني لصحراء سيناء جنوبًا يعني الحدود الشرقيّة الغربيّة لفلسطين كانت قناه السويس.
أحمد البيقاوي: [00:26:04.20]
آها
سليم تماري: [00:26:05.61]
بالتعريف العثماني. جوابًا على سؤالك أطلت عليك قليلًا أنا، في لحظة فارقة كانت انه حين شعروا انّ استقلال بلاد الشام عن تركيا، عن الدولة العثمانية سيكون بإنشاء دويلات داخلها، صار في ردّة فعل من العديد من المثقفين الفلسطينيين في تلك الفترة ضدّ إنشاء دولة لفلسطين خارج السياق الشامي. لأجل ذلك في سنة 1919 نهاية الـ18 لا أتذكر تمامًا، عارف العارف الذي صار لاحقًا عميد المؤرخين. لكن في تلك الفترة كان موظفًا إداريًا بالدولة العثمانية، أنشأ جريدة اسمها سوريا الجنوبية. هذه لحظة فارقة جدًا. يعني عرّف أهميّة الوطن الفلسطيني بتسميته سوريا الجنوبيّة. لماذا؟ لأنه بالنسبه له إنشاء قسم من بلاد الشام اسمه فلسطين سيوقعه في فخ "وعد بلفور". وعد بلفور يعني صار قسم من الانتداب البريطاني والانتداب البريطاني صار ملزَم بإنشاء وطن قومي لليهود. وليس واضحًا إن كان سيكون دولة أو ليس دولة. لكن كان واضحًا انهم سيفتحون باب الهجرة اليهودية لإنشاء بلد اسمه الوطن القومي لليهود. رد فعل على هذه كان، من العديد ليس كل الناس. لأنّ عيسى العيسى مثلًا أصر أنّ هذه بلد مستقلّة "فلسطين" بتسميّة "جريدة فلسطين". لكن كثيرًا من الوطنيين في تلك الفترة خصوصًا حزب الاستقلال الذي كان المحرّك له عوني عبد الهادي من نابلس وآخرون. فكلهم صاروا يعرفوا فلسطين "سوريا الجنوبية" وسمّوا جريدتهم "سوريا الجنوبية" كانت لسان حال حزب الاستقلال، وتعبير لهذه الرغبة "نحن جزء من سوريا. لا يصير أن تقسموننا عن سوريا". وكان في تحرّك قوي جدًا في المؤتمر السوري الأول، المؤتمر السوري الاول الذي كان تقريبًا مؤتمر شامي/ فلسطيني، كان فيه نواب من جميع انحاء بلاد الشام بما فيها نواب يهود من يافا والقدس وصفد الذين نادوا بوحدة بلاد الشام كوحدة واحدة وفلسطين جزء منها.
أحمد البيقاوي: [00:29:05.50]
لأنه يُحكى كتير على النكبة. يعني دائمًا نحكي بحدث النكبة. لكن أودّ أن أسالك لو لم تحدث النكبة نحن ماذا نكون؟
سليم تماري: [00:29:13.89]
سؤال كثير وجيه الحقيقة. يعني لولا النكبة نكون إذا كان ستسير الأمور كما سارت في بقيّة الانتدابات الأخرى. تصير فلسطين واحدة من أربع دويلات أو دول تُشكّل بلاد الشام الكبرى. وتكون علاقتنا يمكن عندنا علاقات قويّة أو ضعيفة.. أتصور أن تكون قوية مع سوريا ولبنان وتكون متوترة مع الأردن لأنه إذا تتذكّر الهاشميون اختاروا ان يكونوا ملوك سوريا عن طريق الأمير فيصل وصار في نكث يعني فيه صار نوع من التنصل عن التزام بريطانيا بتبوأ الأمير فيصل ملك سوريا، وسوريا كانت كل البلد، نتيجة تحالفات مع الفرنسيين فقسّموا البلاد لقسمين؛ سوريا ولبنان مع الفرنسيين وباقي المناطق مع البريطانيين، والبريطانيون كان التزامهم الاساسي للهاشميين. فالذي صار، حين فقد موقعه الأمير فيصل أعطوه العراق صار ملكًا على العراق، والأمير عبد الله الذي كان عنده طموحات عالية جدًا لأن يكون ملك سوريا. أعطوه شرق الأردن التي كانت يعني بلد هامشي ليس له ملامح سياسيّة واضحة. فالملك عبد الله نتيجه هذا التحوّل التاريخي ظلّ دائمًا يرنو إلى أن يكون حكمه يشمل فلسطين. وتحقق ذلك فعلًا بسبب النكبة. يعني لولا النكبة لم يكن صار ضفة غربيّة وانضمّت للاردن. وكانت فلسطين بلد مستقل. وكان في عنده دعائم اقتصادية ويعني تربوية عالية جدًا. كان عنده كادر عالي جدًا في التعليم، مساوي للوضع اللبناني. وإذا ليس أعلى فكان يكون واحد من الدول العربيّة الكبرى؛ حجمها صغير لكن أهميته كبرى. وطبعًا أهميّته كبيرة بسبب كونه موقع الأديان. فالدين بالنسبة لفلسطين بالنسبة لي أنا هو نقمة ونعمة في نفس الوقت. نقمة لأنه كانت الاحترابات الطائفية تصير فيه دائمًا، وصار أيضًا مهوى الحركة الصهيونية التي جابت آخرتنا بالآخر؟
أحمد البيقاوي: [00:32:18.27]
اوك. متى أدركنا وبدأنا نحكي عن آثار النكبة على الهوية الفلسطينية. أو بدأنا ندرك أو نميّز الأثر الفوري، حقيقة؟
سليم تماري: [00:32:29.37]
في مرحلتين هامتين بهذا الموضوع. الأولى هي مؤتمر أرياح سنة 1949 حين بايعت فيه قيادات فلسطينيّة الملك عبد الله بوحدة ما يسمى وحدة الضفتين. يعني صارت المملكة الاردنية الهاشمية عندها عاصمتين؛ القدس وعمّان. فهذه مرحلة هامة جدًا في مصير فلسطين. والمرحلة الثانية كانت. مجيء السلطة الفلسطينية سنة 1993- 1994 والانتخابات 1996، اللي صار في اعادة صياغة هوية للفلسطينيين. لا أعرف إذا تتذكر أنت كنت صغيرًا، يمكن في تلك الفترة كان في نوع من التوتر، طبعًا كانت لحظة درامية ايجابية بالنسبة لمعظم الفلسطينيين لكن كان في توتر فيها. لأن الانتفاضة الاولى عبّأت الرأي العام العالمي والفلسطيني والعربي ضدّ استمرار الاحتلال. كانت مُقادة من قيادات محلية في داخل الضفة الغربية وغزة. يعني غزة والضفة كانوا دينامو ومحرّك الانتفاضة، ومجيئ قوى منظمة التحرير الذين كانوا وقتها مشتتين، قيادة بتونس والكوادر المقاتلة في جميع أنحاء العالم العربي خصوصًا بلبنان، مجيئهم كان إعادة لُحمة للشتات الفلسطيني مع الناس الذين بقوا. كانت لحظة توتر لأنه في ناس كانوا شاعرين إنه الانتفاضة كانت نتيجة كفاح دامي من قبل أهل فلسطين الذين بقوا بفلسطين.
أحمد البيقاوي: [00:34:41.97]
لكن، أليست هذه لحظة متأخّرة في الحديث عن متى أدركنا أنّ أثر النكبة على الهوية. طويل من 48 إلى...
سليم تماري: [00:34:53.37]
مرحلة تالية، ليست متأخرة.
أحمد البيقاوي: [00:34:54.09]
مرحلة ثانية
سليم تماري: [00:34:54.72]
يعني هي مفاصل.
أحمد البيقاوي: [00:34:57.12]
لكن هذا مفصل ثاني أنت أسميته.
سليم تماري: [00:34:59.08]
انت يعني تسألني أو تقترح أنّ الهوية الفلسطينية بُعثت قبل الانتفاضة. أليس كذلك؟
أحمد البيقاوي: [00:35:08.98]
أفكر؟
سليم تماري: [00:35:10.33]
اكيد اه يعني هي الشرارة التي أشعلت النهضة لنسميها، هي حرب الـ 67 وبعد ذلك قمع الاردن والدول العربية الاخرى لأيّ حسّ فلسطيني مستقل عن القومية العربيه، بما فيها الاحتضان لنسميه (الاحتضان القاتل) الذي يمثل أو مثلته الحركة الناصرية بمصر وأحزاب القومية كحزب البعث بسوريا. والقوميين السوريين بلبنان، كله كان احتضان مميت. يعني يمكن خطأ استعمل كلمة مميت كان احتضان قامع، مثلًا، إنشاء حكومة عموم فلسطين بغزة سنة 1979.
سليم تماري: [00:36:15.06]
احتضان الحكم الناصري للثورة الفلسطينية؟ كان احتضان قامع في نفس الوقت لانه كان يكبّل قدرات الفلسطينيين، ان يتحركوا اعتمادًا على قدراتهم الذاتية. والفلسطينيون كانوا عندهم قابلية لهذا الاحتضان لأنهم يعرفون أنّهم لا يقدرون أن يُحرروا فلسطين دون الدعم العربي، لكنّ الدعم العربي أيضًا كان مُقيّدًا. وهذا التقييد وصل ذروته لإنشاء منظمة التحرير في القدس سنة 1964، بمبادرة من الجامعة العربية ومن جمال عبد الناصر تحديدًا، فكانت حركة محتضنة من قبل النظام المصري ومقيّدة له. والدليل على تقييدها أن كل الحركات العسكرية التي تفجّرت في ذلك الوقت كانت تُقمع من كل النظم العربيّة، يعني كان في دعم مصري قليل للفدائيين من غزة. لكن بعد حرب 1956، واحتلال غزة من قبل اسرائيل. بدأ المصريون يقيّدون أي حركات عسكريّة فدائيّة من قبل الفلسطينيين. وهذا الحكي ينطبق على سوريا وعلى لبنان وعلى الاردن أيضًا. ووصل ذروته في "أيلول الاسود" سنة 1970.
أحمد البيقاوي: [00:37:45.53]
أيضًا، أيضًا، بالعودة للنكبة والعودة للانطلاق منها. كيف ساهمت النكبة في خلق هويات متعددة تحت فلسطين؟
سليم تماري: [00:37:55.55]
الهويات المتعددة نشأت نتيجة الشتات طبعًا يعني من أحد أهم نتائج النكبة كانت تشتت وتوسّع الشعب الفلسطيني في أصقاع الأرض. لكن اللاجئين الفلسطينيين عمليا انتقلوا إلى أربع مراكز: إلى جنوب لبنان، لسوريا، لشرق الأردن، وقسم كبير راح على غزة. صاروا سبعين بالمئة من سكان غزة من لاجئي مناطق الجنوب. يعني من يافا وأسدود والجورة وكل قرى الساحل الفلسطيني الجنوبيّة. فصار عندك هوية غزاوية بغزة تحت الحكم العسكري المصري، صار في هوية الشتات الفلسطيني بسوريا ولبنان الذين رفضوا إعطاء حقوق الإقامة الدائمة والجنسيّة للفلسطينيين تحت شعار عدم تقويض حق العودة. يعني كان في هدف سياسي لكن كان في سياسات ديمغرافية لها علاقة بالتوازن الداخلي بسوريا ولبنان. فقط بالأردن الفلسطينيون صاروا مواطنين أردنيين. هذه كانت يعني عمليّة ذكيّة جدًا من قبل الأمير عبد الله أو الملك عبد الله الأول لأنه خلق اندماج بين مجموعتين يمكن تسميتهم اثنيتين عرب لصالح إنشاء دولة أردنيّة حديثة. وإعطاء الفلسطينين المواطنة، أعطاهم نوع من الاستقرار الذي لما يحسه فلسطينيو الشتات في لبنان وسوريا ولا أحسّوا فيه بغزة، لأن الحكم المصري أيضًا لم يعطهم الجنسيّة. طبعًا كثير ناس في تلك الفترة كانوا يرون هذا الإقصاء عن حقوق التجنّس، شيء إيجابي أنه يسمح للناس أن يظلّوا واعين يعني، نار العودة تبقى في أذهانهم.
أحمد البيقاوي: [00:40:25.04]
هذه بالخمسينات يمكن؟
سليم تماري: [00:40:26.54]
بالخمسينات وحتى بالستينات. بعدها صار واضحًا انّ هذ يعني نوع من التمييز الذي يجعل حياتهم العمليّة اليوميّة تصير بائسة جدًا.
أحمد البيقاوي: [00:40:41.69]
في أي بلد بدأنا نرى هذا التمييز في حينها؟
سليم تماري: [00:40:45.38]
تراها أوّل شيء في لبنان.
أحمد البيقاوي: [00:40:46.88]
لبنان بدأت؟
سليم تماري: [00:40:47.84]
آه لبنان، لأن لبنان العنصر الفلسطيني كان جزءًا من المعادلة الطائفيّة التي حاربتها المؤسسة اللبنانية المارونية خوفًا من التغيير الديموغرافي في تركيبة السكان، وكانوا يرون دائمًا أن النضال الوطني اللبناني مع الفلسطينيين يُشكل خطرًا على الهوية اللبنانية. لأجل ذلك بالحرب اللبنانية الأهليّة كان في دائمًا يعني إشارة إلى إنه -طبعًا الحركة الناصرية القومية في لبنان كانت ترى بالفلسطينيين رافدًا وداعمًا لها- لكن في الحرب يعني التحالفات تغيّرت، والنظام السوري ساهم في هذا التغيير في معارك تل الزعتر مثلًا والتحالفات التي لها علاق بموقف سوريا من علاقته في لبنان كمؤسسة رسمية، كلها عملت من الفلسطينيين "كرة المدفع يعني صاروا بين الرجلين"، لكن هذا بنفس الوقت أعطاهم زخم في إضفاء هوية فلسطينية مستقلة قوية جدًا كانت الداعم الرئيسي للحركة الفدائية ولإنشاء الفصائل المقاتلة في منظمة التحرير، وليس فقط فصائل مقاتلة. عندك نقابات عمالية؟ تجمّعات نسائية، ومثقفين، مراكز أبحاث. مثلا المؤسسة التي أشتغل فيها: مؤسسة الدراسات الفلسطينية أنشئت في فردان في لبنان. في بيروت سنة 1963. يعني الهوية الفلسطينية لم تكن عادت إلى الظهور إلّا في بداياتها عن طريق القوميين العرب وعن طريق حزب حركة فتح التي كانت ناشئة في ذلك الوقت. فأنشأوا أولًا مؤسسة دراسات فلسطينية بدعم لبناني قوي من جانب الوطنيين اللبنانيين وعلى رأسهم المفكر القومي السوري قسطنطين زريق وهشام نشابة من لبنان، كان رئيس المقاصد في بيروت، وليد الخالدي المؤرخ الفلسطيني من القدس، وغيرهم ممن ساهموا في إنشاء هذه المؤسسة التي تعنى بالدراسات الموضوعية للصراع العربي الاسرائيلي ولقضية فلسطين والتاريخ الفلسطيني، ثم تبعها "مركز الابحاث" التّابع لمنظمة التحرير وكان رئيسه انيس الصايغ من كبار المفكرين الفلسطينين. طبعًا أنيس الصايغ. وعائلة الصايغ. حوارنة بالاصل صاروا فلسطينيين لأنهم هاجروا من حوران على صفد. ومن صفد على طبريا. فصاروا فلسطينيين. يعني بعملية الانتقال المكاني. وصاروا من كبار المثقفين الفلسطينيين. عندك انيس الصايغ، وعندك الذي كان ممثلنا في الأمم المتحدة، نسيت اسمه. ويوسف الصايغ من كبار الاقتصاديين الفلسطينين الذين ساهموا في إنشاء مركز الأبحاث فصار في موقعين فلسطينيين. يعني حوارات. ويعني منصّات لتفجير الأبحاث الفلسطينيّة والتي كان كثير من روّادها وكتابها، عرب سوريون ولبنانيون ومصريون أيضًا.
أحمد البيقاوي: [00:45:09.89]
وهنا كانوا يناقشون يعني الدافع. او الآن وأنت تحكي أفكر في أن إدراك الفلسطيني لموقعه داخل المعادلات اللبنانية سواء يعني داخل الهويات اللبنانية دفعه أكثر باتجاه تعزيز هويته الفلسطينية أكثر؟ حين حكيت عن لبنان يعني بدأ الفلسطيني يدركها، بالأوّل.
سليم تماري: [00:45:31.88]
لا، الذي عنيته أنه صار في فرز من دعاة الهوية اللبنانية المستقلة، وليس كلّهم كانوا يمنيين بالمناسبة، يعني في عندك ناس يعتبرون حالهم أنّ لبنان لها أصول فينيقية ليس بالضرورة عربية. وهي موقع لنسميها التنوير الحضاري القديم جدًا، ولها شخصيتها الخاصّة والتي طبعًا محرّكها الأساسي كان الفكر الانعزالي الماروني وتحالف المثقفين الموارنة مع فرنسا ضدّ جعل لبنان جزءًا من سوريا الكبرى من أيام الدولة العثمانية بالمناسبة، لأن الدولة العثمانية عملت.. في كان بكل الدول العثمانية ثلاث متصرفيّا مستقله. يعني تُحكم مباشرة من اسطنبول، وليس لها حكم ذاتي، لكن لها هويتها القوميّة: متصرفيّة القدس الشريف وموقعها القدس وهي كل جنوب فلسطين. متصرفية جبل لبنان، بيروت لم تكن جزءًا منها، بيروت كانت ساحل ميناء سوري. ومتصرفيّة جبل لبنان كانت مثل فلسطين يعني مقاطعة مستقلة تحكم مباشرة من "الباب العالي" وكان في وحدة أخرى أظن يمكن ببوسنيا يعني لها خصائص اثنيّة. إمّا كانت غير إسلاميّة/ مسيحيّة أو بالنسبة للقدس الشريف كونها موقع ديني هام جدًا وكان عليه صراع جدًا من القوى الأوروبيّة بعد الحروب الصليبية يعني. كان دائمًا في موقع هام من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا خصوصًا لإنشاء قواعد لهم، قواعد إداريّة في فلسطين. فالدولة العثمانية ردّ فعلها كانت إنه لا هذه سنجق عثماني مستقلّ نحارب فيه الأطماع الاوروبيه للاستيلاء عليه، وهي الصليبية الجديدة، عن طريق اعطاؤه صلاحيّات واسعة في التعليم، في القضاء، في القانون، فكان له مزايا. وجبل لبنان نفس الشيء كان له هذه المزايا.
أحمد البيقاوي: [00:48:13.14]
اوك صار في هويات فرعية. صار في هوية ضفة- غزة- داخل- شتات، والشتات. كان واضحًا أنه بناءً على شكل تعاطي كل دولة مع الوجود الفلسطيني ما فرز خصوصيّة ما. متى ينفع أن نقول انه بدأت مساعي توحيد الهوية الفلسطينية وتوحيد الفلسطينيين على هوية فلسطينية جامعة يعني؟
سليم تماري: [00:48:40.36]
في المؤتمر السوري الأول الذي حكينا عنه سنة 1919.
أحمد البيقاوي: [00:48:45.34]
نحكي ما بعد النكبة صح؟
سليم تماري: [00:48:47.38]
لأ، أحكي أرجع للتاريخ بعد النكبة سنة 1964 في مؤتمر منظمة التحرير بالقدس والتي انتخب فيها أحمد الشقيري. كرئيس لا أعرف اسم الموقع، رئيس اللجنة المركزية او يعني رئيس منظمة التحرير في القدس وكان فيها تمثيل لفلسطينيين من الشتات ومن فلسطين نفسها، واستثني منها عرب الداخل طبعًا، وهذه نقطة هامّة بحديثك أنت، إنه لعند الانتفاضه الأولى. طبعًا لعند الاحتلال كان في يعني رد فعل غريب جدًا وإقصائي لعرب الداخل، مع أنّهم الذين بقيوا في فلسطين وحافظوا على الهوية الفلسطينية الاصلية "كأنهم خانونا". يعني بسبب كونهم مواطنين إسرائيليين صار في نظرة دونيّة واستثنائية وصار في تهميش هائل. وهم طبعًا شعروا بهذا التخاذل، طب نحن الذين بقينا وحافظنا على الشعلة كيف تعاملوننا هكذا؟ وما تغيرت المعادلة إلا بعد الاحتلال الاسرائيلي سنة 1967 وتوحيد جميع أقسام الشعب الفلسطيني تحت الإدارة الاسرائيلية. وقتها عدنا لاكتشاف بعض، وعرفنا أهميّة المثقف الفلسطيني الذي بقي في فلسطين الذين نسميهم اليوم "عرب 48" في الحفاظ على الهوية الفلسطينية. وليس فقط هكذا، يعني تفجير شعلة ثقافية هائلة من خلال مجلات ومؤسسات شعرية وحركة وطنيّة. طبعا في تلك الفترة كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي هو الذي يؤطّر هذه الحركة الوطنية بشكل أممي ثنائي القومية إلى آخره. لكنّه حافظ عليها من خلال يعني توفير منصة مهمّة جدًا للتعبير عن الهوية الفلسطينية من خلال الشعر والأدب: إميل حبيبي، محمود درويش، القاسم، وتوفيق زياد كلهم كانوا نتاج هذه العزلة التي حافظت على الهوية الفلسطينية المستقلة.
أحمد البيقاوي: [00:51:28.48]
طيّب لماذا هذه العزلة؟ بتعرف انا حتى بالسنين الأولى ما بعد النكبة، في قصص كثيرة بمناطق 48 نحن لا نستحضرها. يعني ليست بارزة كثير في سياقاتنا بفكرة إنّه في حدا طلع بال 48 وبقي يجرب يرجع. أو في عائلات طلعت ورجعت. فأنت الآن حين تحكي لي على فكرة العزله إنه أفكر في مثلا أول 10 سنين أو من أول خمس لعشر سنين. أهالي ال 48 الذين طلعوا مثلا على لبنان. ضلهم يحاولوا فعليا يرجعوا فتلاقي عائلة في عكا رجعت بعد 3 سنين وعائلة ثانية رجعت بعد 4 سنين. نظرة انه خانونا هذه متى بدأت؟ ولماذا بدأت؟ يعني او اشيء ثاني فكرة العزلة متى بدأت؟ لأنه مجرد حركة الفلسطينيين تقول لي إنّه ما كان في. يعني ما كان في عزل وكانت الناس تتحرك. ولم يكن (تسمية) الداخل أو هؤلاء عرب الداخل وهؤلاء فلسطينيو الـ 48.
سليم تماري: [00:52:26.54]
لا كان في، لكن كانت مستترة. يعني...
أحمد البيقاوي: [00:52:30.63]
من الأول..
سليم تماري: [00:52:31.59]
الناس كانوا يذهبون ويأتون. يعني اول 3 سنين من الاحتلال من 1948 كان في حركة قوية تهريب، تهريب سكان من لبنان وسوريا لكن أكثر من لبنان وسوريا وقليلًا من شرق الأردن. من الضفة الغربية لداخل اسرائيل، كانت الحدود ما تزال هشّة. هيرتسوغ الرئيس الإسرائيلي الحالي كان رئيس وحدة هدفها محاربة ما يسمى بتسلل الفلسطينيين. وكانوا يسمونهم تسلل أمني لكن هم في الواقع كانوا فلاحين يحاولون أن يرجعوا لأرضهم وفي كانوا يأخدون محاصيل من أرضهم ويرجعوا، يذهبوا ويرجعوا. فكانت الحدود هشة. على أرض الواقع كان في نوع من مسامات/ الثغرات داخلة طالعة بحدود فلسطين التي صارت "دولة اسرائيل" لكن على المستوى الرسمي وعلى المثقفين الذين كتبوا في تلك الفترة كان في موقف غريب ويتّسم بعقدة الذنب من الخروج وانعكست في موقع يعني متناقض من الناس الذين بقوا في الداخل. من ناحية كان في اشارة لصمودهم لكن بنفس الوقت كان في إهمال لإنجازاتهم. لم يكتب أحد عن أدبهم إلّا بعد 1967 يعني اكتشفنا انه في شعر فلسطيني قوي جدًا يطلع من الداخل. شو اسمه حسين. الشاعر الفلسطيني من المثلث. نسيت اسمه؟ حسين.. محمود درويش بعد ذلك. بروز إميل حبيبي كأديب رائد، توفيق زيّاد، القاسم كلهم تم اكتشافهم، وكانوا ما يزالون شبابًا صغارًًا في تلك الفترة، وكانوا يكتبوا كانوا يعني معروفين في الداخل لطن صدفت إنه نهاية الحكم العسكري لعرب الداخل سنة 1966 أي سنة قبل الاحتلال، فنحن صرنا تحت حكم عسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبنفس الوقت الذي رُفع الحكم العسكري عن عرب الداخل. فهم عمليًا بقوا تحت إدارة عسكرية لا يقدروا أن يتحركوا فيها إلا لبعض سكان المدن بين 1948 -1966 وهي عمليًا بداية الاحتلال الثاني.
أحمد البيقاوي: [00:55:41.27]
الآن أحداث كثيرة مرّت يعني كبيرة مرّت علينا، من 1967 السبعينات 1973 يمكن كمان 1988. توقيع اوسلو، انتفاضة ثانية، اذا أريد أن آخذ أن هذه الأحداث أثرت على نظرة الأجيال لأنفسهم أو تعريف الأجيال لأنفسهم أو مدى ادراك وتعريف الفلسطنيين لانفسهم على الأجيال المختلفة. إذا أريد أن أكمل على مناطق 48 فقط، لفتني كيف تحكي عنهم يعني. حكينا على 1967 ونكمل. فعليًا إذا بدنا نحكي الانتفاضة الأولى كيف كان أثرها فعليًا وما بعدها من أحداث أساسيّة.
سليم تماري: [00:56:22.75]
أثرها يكون جيّدًا إذا قدرت أن أشرب الماء، لأنه "نشف ريقي"
أحمد البيقاوي: [00:56:29.62]
عرفت اسم الشاعر؟
عُلا وتد: [00:56:30.85]
راشد حسين من قرية اسمها "مصمص"
سليم تماري: [00:56:36.07]
ما اسمه الأول؟
عُلا وتد: [00:56:37.00]
راشد حسين.
سليم تماري: [00:56:39.13]
راشد. حسين. آه. أنا كنت أعرفه من نيويورك راشد، مسكين مات بظروف مآساوية بنيويورك، كان قريبًا من ادوارد سعيد كان مقرّبًا له يعني. راشد حسين كثير شاعر مهم.
أحمد البيقاوي: [00:56:57.19]
أنا والله كنت أريد أن أسالك لكن إذا يعني أحببت أن تشاركي، شاركي. لأنه أنت من المثلث فكان يجب أن تعرفيه.
سليم تماري: [00:57:05.35]
هو من المثلث أليس كذلك؟
سليم تماري: [00:57:09.37]
من أي بلد؟ راشد حسين.
عُلا وتد: [00:57:12.34]
"مصمص" جنب أم الفحم مصمص.
سليم تماري: [00:57:14.50]
اه ايوة. في أنا عندي ماء، سأحضرها. الآن حين يبث هذا البرنامج يظهر كأننا ندردش؟ يضل مكمل؟ يعني يجب أن أحتاط لما أقوله الآن؟
عُلا وتد: [00:57:42.52]
ههه إذا في شي أنت ستقطّعه إذا أحسسته "مش تمام".
أحمد البيقاوي: [00:58:03.10]
أحداث كبيرة مرّت علينا. وأحببت كيف أنت ذكرت.. يعني لفتني كيف ذكرت الـ 1967 كحدث فعليًا غيّر بتعريف الفلسطينيين في الـ48 لأنفسهم. كنت اسالك على كل الفلسطينيين، على كل الهويات كيف فعليًا الأحداث الكبرى التي مررنا بها جعلتنا نعيد تعريف أنفسنا أو نعيد صياغة انفسنا مع كل حدث كبير مررنا فيه. من 1967، 1988، اوسلو. انتفاضة أولى. انتفاضة ثانية وغيرها. لكن إذا سأكمل فقط بسياق مناطق الـ48 لأن التفاصيل هناك اوضح في سياق الهوية كما أحس. حكيت لي عن 1967، إذا أريد أن أكمل أو تذكر لي محطات بالمحطات الكبيرة او بالأحداث الكبيرة، كيف انعكست فعليًا على الهوية الفلسطينية عند أبناء الـ 48.
سليم تماري: [00:58:53.30]
بالنسبة لتجمّعات الـ 48؟
أحمد البيقاوي: [00:58:57.14]
لا فقط فلسطينيّة الـ 48 تحديدًا، فلسطينيّو الداخل او عرب الداخل.
سليم تماري: [00:59:02.45]
الآن في ناس ينسون هذه النقطة، إنه في 1967 صار شيئين مهمين، انقطعت فلسطين أو بالأحرى غزة والضفة الغربية عن العالم العربي. صار الشمال كثير صعب، وانفتحت بنفس الوقت على داخل التجمّعات الفلسطينية داخل "إسرائيل" وبروز ما يسمى "عرب الداخل" او "عرب 48". كانت هذه لحظة فارقة مهمّة جدًا لأنه أول شيء.
أحمد البيقاوي: [00:59:37.69]
قبلها ما كان اسمهم عرب 48؟!
سليم تماري: [00:59:40.99]
قبلها لم يكن في أي تواصل. يعني انا أتذكر مرّة بالسنة في عيد الميلاد فقط للمسيحيين العرب من الداخل كان يسمح لهم أن يأتون 48 ساعة ليزوروا اقاربهم في الضفة الغربية وأحيانًا في الأردن، الضفة الغربية والاردن كان نفس الشيء. هؤلاء أناس أغراب، يعني صاروا ناس انفصلنا عنهم كليًا. فلما جاءت حرب حزيران انفتحت الدنيا واندفع عرب الداخل على الضفة الغربيّة. يعني اخذوا منفس برؤية أهاليهم من جهة ثانية. يعني لا تنسى إنه الناس كانوا مقسومين عائليًا أيضًا، ليس فقط بين القرى والمدن. إنه كانوا عائلات منقسمة جزء منها بقي بالداخل وجزء بالضفة الغربية وغزة. في تلك الفترة، الناس ينسون، فتحت كليًا الطرق. انا كنت أسوق بسيارتي من رام الله لدهب. بتعرف أين دهب؟ في سيناء. كنت بسيارتي أذهب من رام الله على غزة. ومن غزة على العريش. ومن العريش على "سانتا كاترينا" وصحراء سيناء، على منطقة الساحل المصري بالبحر الأحمر، يعني هذا النوع من الحريّة. الحريّة التي نتجت عن طريق استيلاء "إسرائيل" على كل مناطق فلسطين وسيناء، فتحت آفاقًا جديدة للناس. فهي من ناحية كنّا شاعرين بالهزيمة، إنه قُضي علينا. لكن فُتح عمليًا تواصل الشعب الفلسطيني بكل انحاء أجزائه. ووقتها اكتشفنا بعضنا، واكتشفنا قديش عرب الداخل كانوا محافظين على هويتهم، وعبّروا عنها بطريقة يعني كتير مصقولة من خلال أدبهم ومن خلال شعرهم. وهم اكتشفوا أيضًا بعدًا ديمغرافي كانوا متشوقين له، وهو حريّة التفاعل مع ثقافة عربيّة يعني قمعت في الداخل، قُمعت لأنه صار في عملية الأسرلة في التعليم إلى آخره، فانفتحت لهم آفاق جديدة وأتذكر في تلك الفترة صار في بداية منصّات ثقافيّة هامّة جدًا. "المنتدى الملتقى الفكري العربي بالقدس". "المنتدى العربي". "نادي الغد". الذي كنت ناشطًا فيه، في القدس، وكثير كثير مثلها وخصوصًا بالحركة المسرحية، والحركة المسرحية جمعت بين عرب الداخل وبين سكان الضفة الغربية بما فيها القدس.
سليم تماري: [01:02:51.89]
في عندك مجموعة البراعم الغنائية، مجموعات غنائيّة جديدة. الآن سأتذكر اسمها. ومسرح الحكواتي. مسرح الحكواتي. لعب دور كثير مهم بتاريخ الحركة الثقافية الفلسطينية في بداية الاحتلال لعند نهاية السبعينات. وكانت تجمع بين الغزيين وناس من الضفة ومن عرب الداخل خصوصًا من الناصرة وحيفا ويافا. وكمان الجامعات. يعني في جانب ثاني مهم جدًا انه نحن انقطعنا عن العالم العربي. فصار في اهتمام بتطوير. يعني أين كانوا يدرسوا اهل فلسطين؟ كانوا يروحوا على جامعات القاهرة. جامعات مصرية. جامعة دمشق وكثير منهم على لبنان. الذين معهم أموال يدرسوا بالجامعة الامريكية، وفي فترة كانت الجامعة الامريكية فيها بين الطلاب العرب. اغلبية فلسطينية. في فترة. بسبب عدم وجود مؤسسات تعليميه في الداخل. والاردن طبعًا. فانقطاعنا عن العالم العربي أدى الى تطوير منصات ثقافية، وكان في نوع من الحرية لأن "إسرائيل" كانت تقمع كل شيء سياسي. لكن كان في نوع من التسامح مع وجود مؤسسات ثقافية. فنمت الجامعات، جامعة بيت لحم، جامعة بيرزيت الاولى كانت، جامعة النجاح. وفي غزة 7-8 جامعات في تلك الفترة. كلها نتجت عن طريق انعزالنا عن العالم العربي. وعدم قدرة الطالب الفلسطيني يدرس إلّا بجامعات اسرائيلية. فتطوير المؤسسات الثقافية العربية كان احدى نتائج احتلال الـ67 وانقطاعنا عن العالم العربي، وهذه المنصات لعبت دورًا كبيرًا في بلورة الهوية الفلسطينية الجديدة، وصار في نوع من التواصل بينها وبين ما صنعته منظمة التحرير في لبنان والاردن وسوريا. من يعني وعي سياسي/ عسكري أيضًا من الفدائيين والفصائل المكافحة، أيضًا تبلورت.. كان في انقطاع ليس فكريًا، وانما انقطاعًا جغرافيًا بين الحركة السياسية في الداخل وبين الحركة الوطنية التي تبنتها منظمة التحرير في أرض الشتات، في تجمعات اللاجئين في الشتات الذين كانوا عماد الثورة الفلسطينيّة.
أحمد البيقاوي: [01:06:00.89]
إذا اريد أن أقول ان الإسرائيليين بالمراحل الأولى كانوا يتعاملون مع الوجود الفلسطيني بحد ذاته كخطر، فندفعه باتجاه التهجير او نقتله. بعد ذلك صار في سياسات للتعامل مع الوجود الفلسطيني داخل فلسطين كلها، في فوارق حتى أنت وأنت تحكي سمحوا في مكان، في مكان ثاني ما سمحوا، صار في حدث هنا، وهناك لا يسمحون به، في فوارق بشكل تعاطي الإسرائيليين والاحتلال مع التواجد الفلسطيني داخل فلسطين، كم عزز هذه الفوارق وساهم فعليًا في تعزيز الهويات الفرعيّة إذا ينفع أن نسميها؟
سليم تماري: [01:06:45.43]
في البداية كان الاهتمام الإسرائيلي ان يخلقوا نخبة فلسطينيّة موالية. يعني كان في محاولات. الحكم الاداري الاسرائيلي الذي كان مركزه بيت ايل في الضفة الغربية، وبغزة. كان اهتمامه ان يسمح في نوع من يعني المنصات، ما كان في قمع مباشر للفكر. كان في محاولات كسب تأييد. وهذا صار في صراع دامي بين يعني منصات منظمه التحرير. وبين محاولات الإدارة الإسرائيلية عن طريق الصحافه مثلًا ان تؤثّر على رأي عام مستقلّ عن الأردن. يعني كان في تبني لمشروع. انقسمت القيادة الاسرائيلية طبعًا بين دايان والون، يعني قطبين. السياسات المختلفة الاسرائيلية كانت موشيه ديان من ناحية، ويغال آلون نائب رئيس الحكومة (الإسرائيلية) في تلك الفترة، كان ينادي بإرجاع الضفة الغربية للأردن ويمكن حتى غزّة. يعني يعملوا لها ممر وصنع سلام مع الأردن لصالح تحويل القضية الفلسطينية للأردن، أنّ الاردن هي فلسطين بنظرهم. وحزب العمل كان كثير شديد في هذه الفكره. ومقابلها كان في موشيه دايان الذي كان يقول لا، هذه أرض إسرائيل الكبرى يجب أن تبقى تحت (سيطرتنا) ونعالجها فقط بالطرق الاقتصادية، نفتح سوق العمل، البضائع الإسرائيليّة تصير جزءًا.. يعني الضفة الغربيّة، بتصير وغزة جزء اقتصادي من "إسرائيل" دون اعطاء المواطنة لسكانها. فيصير في نوع من الكيانية الفلسطينية التابعة لاسرائيل. ويُقضى على القضيّة الفلسطينيّة عن طريق الاقتصاد. فصار في تطبيع اقتصادي للعلاقات؛ الضفة مع إسرائيل بشكل هائل.
سليم تماري: [01:09:20.16]
وصار في حركة عمال، ولم يكن في تصاريح في تلك الفترة. لا تصاريح سفر ولا تصاريح عمل. الون كان برأيه ان وجود الفلسطيني داخل اسرائيل يُشكّل قنبلة ديمغرافية ستقضي على كيان الدولة اليهودية. وبالتالي كلما تخلصنا منهم اسرع يكون أحسن. نبقي القدس ونعمل ممر في غور الأردن. لكن الضفة الغربية بمجملها تروح للاردن، وبدأت عملية مفاوضات مع الأردن في تلك الفترة، انتهت بقرار سنة 1988 ما يسمى بفك الارتباط، يعني منظمه تحرير تفاوضت مع الملك حسين مع الأردن إنه منظمه التحرير تصير ممثل للشعب الفلسطيني في إنشاء كيان فلسطيني مستقبلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعًا لم يكونوا يستعملون هذا التعبير لأنه الفكرة إنه التحرير على كل الأراضي الفلسطينية. لكن عمليًا صار في نوع من التوافق الاردني الفلسطيني. الاردن ترفع عنا الجنسيّة، لاننا كنّا اردنيين لسنة 1988 كنا مواطنين اردنيين نسافر بوثائق اردنية عن طريق "سيباسيه" وثائق سفر إسرائيلية فلما أزيلت الجنسيّة الأردنيّة عن الفلسطينيين، صار في فراغ سياسي مقصود كان هدفه بداية يعني تحرير السكان من "إسرائيل" إمّا عن طريق المفاوضات او في تلك الفترة كان في أمل إنّه قدرات المقاومة تحرر الأرض. ليس مهمًا. المهم في تلك الفترة ان الهويّة الفلسطينية بعثت بقوة عن طريق إنهاء العلاقة التاريخيه بين الأردن وبين الضفة الغربيّة.
أحمد البيقاوي: [01:11:35.48]
وصلت قهوتك.
سليم تماري: [01:11:38.18]
يسلمو هالايدين. شكرًا شكرًا.
أحمد البيقاوي: [01:11:49.16]
صحّة وعافية.
سليم تماري: [01:11:50.06]
شكرًا.
أحمد البيقاوي: [01:11:52.37]
بالتوازي مع هذا الحكي. أنت تعرف قبل، كأنّك أحيانًا تُعرّف حالك بـ 48 فتقول "احنا"، بعدها تحكي "احنا" في الضفة. ولا أنا الـ "احنا" هذه لا أفهمها؟.
سليم تماري: [01:12:04.62]
أيوة.
أحمد البيقاوي: [01:12:05.19]
تتنقّل من مكان لمكان بتعريف نفسك؟
سليم تماري: [01:12:08.28]
اكيد اه، لانه يعني ليس فقط مررنا بمراحل كثيرة، لكن أنا ليس ليس لديّ هوس، يعني أنا بقومي عربي من البداية يعني، لذلك لم يسبق لي أن شعرت بأن إنهاء القومية الفلسطينية لصالح انتماء سوري أو شاميّ أو عربيّ تشكّل مشكلة عندي. ليس لديّ الهوس الفلسطيني الموجود عند عرب الشتات الذين شعروا أن فلسطينيتهم هي مدموغة على جبينهم.
أحمد البيقاوي: [01:12:46.05]
في الداخل يعني انت تعرّف حالك ابن ضفة غربية أم ابن الـ 48؟ إلا انه أقول أننا حين نكون نتحدث بخصوص الـ 48 فتصير تحكي "احنا". فأنا مش فاهم الـ "احنا" هذه هل هي في سياق محلي 48، أم سياق محلّي في الضفة؟
سليم تماري: [01:13:01.51]
أنا أقول لك السبب لهذا، هي ليست قضية فكرية. أنا مولود في يافا، وأشعر دائما من خلال عائلتي انه موطني هي مدينة يافا، وقسم لا بأس به من عائلتي بقيوا في يافا حتى اليوم ونزورهم ويزورونا. فيعني لم أشعر بأنني انسلخت عن هذا الوطن لأننا بقينا في فلسطين، وذهبنا فترة قصيرة للبنان. بينما إن حكيت مع الفلسطيني الذي نشأ في مخيم اليرموك، أو في النيرب بحلب، أو في لبنان خصوصًا _فلسطينيي لبنان_ نتيجة الحرب القاتلة التي دخلوا فيها عندهم يعني نوعين من رد الفعل؛ انتماء فلسطيني متطرّف في هويّته، أو إنكار، يعني يذهبون إلى السويد فيصبحون سويديين. نحن الذين بقينا في الضفة الغربية ليس عندنا هذا النكد _لنسمّيه- وأنا يعني مع كل الوضع البائس للعالم العربي بالنسبة لي ثقافتي العربية هي تكليل لهويّتي، وأجد يعني موطني هو فعلًا بلاد الشام.
أحمد البيقاوي: [01:14:36.74]
نحن خلال حديثنا يمكن قفزنا أو ما حكينا كثير عن مرحلة الانتداب البريطاني، لكن اذا بدي أحكي إنه في تلك المرحلة أيضًا كان هنالك سياسات ما وأيضًا أثرت. هل بنقدر نقرأ أو نتبنى ادّعاء انه السياسات هي محو أو تفكيك للهوية الفلسطينية؟ التي صارت مع الاحتلال هي امتداد لما كان أيام الانتداب البريطاني، وهنا يوجد مشروع فعليًا يعني مستمر ومتجدّد؟ أم أن هناك شيء فارق يحكي انه لا، بل هنا يوجد ثمّة مشروع جديد؟
سليم تماري: [01:15:11.40]
أكيد هناك مشروع جديد، لكن لا تنسَ انه في فترة الانتداب ما كان في محاولة محو للهوية الفلسطينية. كان هناك محو لمشروع استقلال فلسطين كبلد عربي؛ لأن الثقافة الفلسطينية كانت مزدهرة جدًا في فترة الانتداب في الصحافة والإنتاج الفكري الأدبي..إلخ. وجزء منها كان تفاعل ديناميكي جدًا إيجابي مع مصر من ناحية ومع لبنان وسوريا من ناحية ثانية، وكان هناك يعني حراك قوي جدًا. السكاكيني مثلًا من أهم المفكرين الفلسطينيين وجد ضالّته بمصر، يعني مصر كانت تعطيه منبر لكتاباته فكان يكتب في القدس، كان يكتب في القاهرة، وصار عضوًا في المجمع العربي في القاهرة. كثير من الفلسطينيين كانوا يعتبروا أنفسهم مفكرين عرب، وأحيانًا يسمُّون أنفسهم فلسطينيين، لم يكن هنالك نوع من التناقض بين هؤلاء، الذي حدث بعد الـ 48 طبعًا انه قمعت الهوية الفلسطينية، ليس فقط في "اسرائيل" بل قمعت في العالم العربي أيضًا؛ لأنهم أصبحوا يخافون منها، الحركة الناصرية كانت تخاف من القرار الفلسطيني المستقلّ وصار هنالك تبنّي له، وفي لبنان وسوريا أصبح هنالك قمع من خلال الاحتواء، يعني حزب البعث وبشكل أقل الحركة الشيوعية احتوت الفلسطينيين كمحاولة ربما ذلك ليس بالضرورة عن وعي، لكن كانت من نتائجها أن الفلسطينيين أصبحوا عروبيّين أكثر من العرب. وأصبح هنالك قيادات قومية لحزب البعث موجود فيها فلسطينيين كثُر، قيادات الحركة القوميين العرب الناصريين: جورج حبش، ونايف حواتمة وآخرين كانوا جزء من الحركة القومية العربية، ليش؟ لانه بنظرهم لا يمكن تحرير فلسطين عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، بل لا بد أن يكونوا جزء من حركة عربيه شاملة، والتي تساعد فلسطين لتنهض من أول وجديد. ومع حرب فيتنام صار هنالك تبنّي لصياغة جديدة انه بدنا هانوي فلسطينية(نموذج مقاومة سُطِّر في حرب فيتنام)، والتي كانت بيروت أو عمان كنقطة انطلاق يعني.
أحمد البيقاوي: [01:18:08.50]
الآن خلال حديثك عن دور العرب، في البداية راحوا باتجاه العرب انه احنا لا نريد إعطاء جنسية للفلسطينيين، وبدنا نحافظ على هويتهم الفلسطينية، بعد ذلك الآن نحكي عن محطة ثانية أنهم أصبحوا يتعاملون مع الفلسطينيين كونهم أصبحوا عروبيين أكثر من العرب وبالتالي صاروا مشكلة! برأيك قدّيش استغرقوا العرب وقت أو ما الأحداث؟ أو إذا كان ثمّة ظرف ما جعلهم ينظرون بهذا المنظور أو أن يعملوا هذا التغيُّر.
سليم تماري: [01:18:34.33]
إنه العرب يكون عندهم تبني للفلسطينيين على حساب قضيّتهم.
أحمد البيقاوي: [01:18:39.85]
في البداية.. في البداية العرب كانوا داعمين او يعززوا فعليًا بالهوية الفلسطينية، تمام. وبعدين رأوها ورطة.
سليم تماري: [01:18:48.06]
اه.
أحمد البيقاوي: [01:18:48.48]
يعني ورطة أو مشكلة، كم أخذهم وقت إلى أن رأوها ورطة أو مشكلة؟
سليم تماري: [01:18:52.92]
ليس وقت الذي أخذهم، بل أخذتهم أحداث. يعني حرب أيلول التي كانت حرب دامية جدًا بين الفصائل الفلسطينية والنظام الأردني والحرب الأهلية في لبنان. بمصر يختلف الوضع؛ لانه مصر الوجود الديمغرافي الفلسطيني كان خفيف جدًا، كان في حكم إداري في غزة انتهى سنة 1967 فكان في صراع بين الحركة القومية الناصرية أن تتبنى فلسطين، وهذه انتهت بحرب الـ67 لأن النظام المصري قد انهار نتيجة.. هو ليس نتيجة تبنّيه لفلسطين لكن أحد أبعاده كانت ان التبني المصري لقضية فلسطين أدّى إلى هزيمة مصر في حرب الـ 67. وأيضًا بروز قيادات من السادات وآخرين التي وجدت انه يجب الوصول لحل في المفاوضات ويكفينا فلسطينيين. وجع رأس بالنسبة لنا.
أحمد البيقاوي: [01:20:07.84]
منظمة التحرير ماذا كان لها دور في سياق ونقاش الهوية الفلسطينية؟
سليم تماري: [01:20:13.42]
منظمة التحرير لعبت دور كثير مهم في محاولة فصل التبنّي العربي للمنظمة من خلال بروز القرار الفلسطيني المستقل الذي تبنّوه بالدرجة الأولى فتح كحركة وطنية كانت في صراع مع الشقيري حول قيادة منظمة التحرير والفصائل اليسارية التي تمثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. وهناك أيضًا جبهات؛ النضال العربي، وجبهة التحرير والتي كانت فصائل فلسطينية تابعة لنظم عربية بالعراق وسوريا خصوصًا في العراق وسوريا. لكن بالأساس كانت الحركة القومية العربية التي تمثلت بفلسطين من خلال الجبهة الشعبية بقيادة جورج حبش، والجبهة الديمقراطية بقيادة (نايف) حواتمة، مع فتح هؤلاء الثلاثة كانوا كما يمكننا القول أشبه بفوَّهة المدفع الذي فصل منظمة التحرير عن تبنّيها العربي والمصري خصوصًا، فكان الصراع بين مصر الناصرية، وبين منظمة التحرير كجهاز فلسطيني مستقل عن الحماية والتبني العربي.
أحمد البيقاوي: [01:21:47.35]
هل كان هناك جهود ساهمت؟ يعني بعرف انه مثلًا كان في جهود لهم على الفلسطينيين في أمريكا اللاتينيه؛ لتعزيز الهوية الفلسطينية، لانهم رأوا فعليًا _فرضًا_ أن هناك نقاش على موضوع اللغة، فالفلسطينيين الموجودين هناك ليسوا على تواصل معنا نتيجة أزمة اللغة الموجودة والأجيال التي تطلع، فاشتغلوا فعليًا على برنامج يتعلق باللغة العربية. يعني في برامج بهذا القدر واضحة انهم اشتغلوا حتى يعمِّموا أو يعززوا الهوية الفلسطينية الجامعة؟
سليم تماري: [01:22:22.12]
هذه من الجانب الثقافي نقطة جدًا مهمة، والتي هي مثقفي الخارج الأمريكي في الجنوب والشمال. لكن برازيل، مكسيك، تشيلي.. عندك شيء اسمه الرابطة القلمية والتي كان نشيط فيها إيليا أبو ماضي، وفرح أنطون ولفترة قصيرة السكاكيني حين كان في نيويورك. الرابطة القلمية لعبت دور كبير في بلورة الوعي العربي السوري، وسوريا كانت هي بلاد العرب يعني الفلسطينية كانوا شوام (بلاد الشام) وكما تعرف في البرازيل هنالك تعبير "تركو" للعرب الموجودين في المهجر الأمريكي كانوا يقولوا "تركز" لأنهم كانوا يأتون بوثائق عثمانيّة يفكرونهم أتراك. فكل الفلسطينيّة وأهل الشام كانوا "تركز" لليوم حتى بتعبير تركو بالمكسيك والبرازيل، أقل بتشيلي يستعملونه لليوم عن العرب. لكن الرابطة القلمية كانت رابطة كثير مهمة لأنها عبأت مثقفي أمريكا اللاتينية وبعدها أمريكا الشمالية لصالح استقلال فلسطين. يعني كانت جزء هام من عملهم للحفاظ على فلسطين من مخالب الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، فكانوا يلعبون دورًا كبيرًا في هذا المجال. والسوريون واللبنانيون كانوا جزءًا من هذا النضال؛ لأنهم كانوا أغلبية بين المهاجرين. والفلسطينيين كانوا فصيل مهم جدًا.. أهم بلد راحوا عليها في تلك الفترة كانت التشيلي لأنه لليوم أغلبيّة الفلسطينيين في المهجر موجودة في تشيلي.
أحمد البيقاوي: [01:24:21.81]
الآن هؤلاء الفلسطينيين الموجودين هناك، بالسياق الذي تحكيه. أمس كيف كنّا نحكي. هم أيضًا موجودون من قبل النكبة.
سليم تماري: [01:24:30.92]
من قبل الحرب العالمية الأولى.
أحمد البيقاوي: [01:24:32.93]
اه متى صاروا فلسطينيين؟
سليم تماري: [01:24:34.28]
في الحرب العالميّة الأولى...
أحمد البيقاوي: [01:24:35.93]
على الحسبة الخاصّة بنا يعني على سؤال النكبة.
سليم تماري: [01:24:39.17]
نعم كانوا يقولون نحن فلسطينيون، وأحيانًا يقولون نحن سوريون؛ لأنه مثلًا السكاكيني حينما كان في نيويورك، كان يقول أنا سوري من فلسطين، هكذا كان يعرّف عن حاله. أنا مقدسي سوري من فلسطين. هذه هويته كانت، وكانوا أصحابه للسكاكيني من يهود القدس ويهود حلب ممن كانوا يعتبرون حالهم من بلاد مقدّسة يعني خصوصًا يهود القدس كانوا يعتبرون حالهم فلسطينيين، وكانوا يحكوا عربي، كان عندهم حوار قوي جدا معهم بهديك الفترة وأخذ هويتّه الانسانية من هذا الحوار هو، السكاكيني حين كان بامريكا كان صديق لصاحب الجامعة، جريدة الجامعة وهو فرح انطون شخصية هامة جدًا من "شوام مصر" الذين انشأوا جريدة الجامعة، ونقلها على نيويورك هربًا من القمع الرقابي بمصر. وصارت رابطة قوية جدًا بينه وبين السكاكيني. مذكّرات السكاكيني تُشكّل مصدرًا هامًا لدراسة الوعي العربي بالمهجر في تلك الفترة. كان في مثقفين عندهم مجلات وجرائد. "الهدى" مثلا اشتغل فيها السكاكيني كانت لسان حال مثقفي الساحل الشرقي في امريكا الشمالية، وبقيت تنتشر حتى قبل 15 سنة فقط. "الهدى". طبعا جبران وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة كانوا من أهم المثقفين اللبنانيين الذين نشطوا بالرابطة القلمية في تلك الفترة.
أحمد البيقاوي: [01:26:43.76]
اذا نرجع للبنان ولمنظمة التحرير. أخذت فعليًا منظمة التحرير او استحوذت او حصرت القرار او اخذته من العرب. وبعدها صار في نقاش على فكرة الكفاح المسلح كتعريف للشرعيّة الفلسطينيّة والهويّة الفلسطينية أكثر. بمعنى من فلسطيني أكثر؟ نقدر هنا أنا نأخذ هنا أيضًا أنه بهذه المرحلة، فكرة الكفاح المسلح بحدّ ذاتها صارت معيار جديد بتعريف الفلسطيني أكثر من الثاني؟ في هذه المرحلة؟
سليم تماري: [01:27:17.99]
يعني كانت معيار هام بتمييز شيئين: الاول ان الكفاح المسلح مع انه صار شعار النضال الوطني في تلك الفترة، لكن الكل عارف انه هو الهدف مثلما ذكر يزيد صايغ في كتابه عن الدولة الفلسطينية. الكفاح المسلح كان إطار لبلورة وحدة القرار الفلسطيني باستقلال عن الوصاية العربيّة، يعني ولا حدا من المقاتلين ولا الاستراتيجيين الفلسطينيين كان يفكر إنّه فعلًا إن القرار العسكري يقدر يحرر فلسطين من "إسرائيل" لكن بيقدر يحررها من الوصاية العربية. هذه نقطة هامّة جدًا. وفي ناس اتهموا هذا التحرير بالتهور اولًا عن طريق الاصطدام بالنظام الاردني خطف الطائرات وكل هذا عن طريق شعار الكفاح المسلح، وثانيًا عن التضحية بقسم كبير من الفدائيين الفلسطينيين لصالح معركة تكتيكية خاسرة. لكن الناس ينسون أن الكفاح المسلح لعب دور كبير في تعزيز الهوية الفلسطينية المستقلة عن الوصاية العربية كان هذا أحد أهدافه لكن من مشيئات القدر. ويمكن تقصير استراتيجي بالفكر الفلسطيني انهم وقعوا في حروب داخليه كانوا يعني في حل منها بالاردن بأيلول، وبلبنان في الحرب الأهليّة اللبنانية حين صاروا طرفًا بالاحتراب الداخلي والذي أنقذهم من هذا المصير هي الانتفاضة الأولى. الانتفاضة الأولى برهنت للعالم كلّه ولإسرائيل أنه لا يمكن الاستمرار في الحكم العسكري في الاحتلال الاسرائيلي على المناطق العربية على فلسطين. ويجب أن نلاقي لها حلًا. الانتفاضة الأولى لعبت دورًا هامًا في فك هذا الحصار. ليس فقط عن فلسطين أيضًا عن القرار الفلسطيني الذي وصل لمعضلته الكبرى سنة 1982 بالاحتلال الاسرائيلي للبنان وتهجير القيادات الى تونس والجزائر. فالانتفاضة الاولى كثير مهمة في كونها كانت مرحلة بداية انتقال الكفاح الفلسطيني من الخارج إلى الداخل. ومحاولة إقامة دولة فلسطينية، بالنّهاية طلعت خاسرة يعني لكن إنّه كان تحوّلًا هامًا في الهوية الفلسطينية والعمل السياسي الفلسطيني.
أحمد البيقاوي: [01:30:26.01]
وكان يعني بين الفلسطينيين بينهم وبين بعض. الآن أنت تحكي بيننا وبين العرب. بين الفلسطينيين وبين بعض؟ كان عامل مهم؟
سليم تماري: [01:30:34.02]
أكيد. لأنه انا أتذكر -انا كنت طالب ببريطانيا في نهاية السبعينات- كانت معارك طاحنة تصير، معارك يعني فكرية سياسية بداخل الحركة الطلابية بين الناس الذين تبنوا شعار الدولة الفلسطينية التي تبناها اليسار الفلسطيني وفتح مقابل الناس الذين كانوا يعني متعاطفين مع صدام حسين مع حزب البعث السوري. إنه هذه مصيدة يجب أن نهرب منها عن طريق طرح شعار التحرير الشامل.. قرار الدولة الفلسطينية كان كأنه خيانة لاستراتيجية التحرير. وداخل الحركة الطلابية صار في صراع دامي جدًا. وكان الحكم العراقي والسوري يلعبوا دور كبير في تعزيز النضال ضد الطلاب الفلسطينيين الذين كانوا يعتقدون انهم مثلا.. فتح او الجبهة الديمقراطية كانوا ينادون بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وبعد ذلك الجبهة الشعبية أخذت موقعًا وسطيًا يعني مع التحرير الشامل من ناحية، ومن ناحية ثانية مع نوع من التسوية التي تعطي القرار الفلسطيني المستقل قدرته على المحاورة.
أحمد البيقاوي: [01:32:11.16]
وصف المصيدة هذا احكى يمكن او او يذكر بسياق الاونروا. يذكر بسياق ان الفلسطينيين في بداية تأسيس الاونروا وتعاملهم مع ملف اللاجئين كانت على انه هنا في مصيدة موجودة، وفي منظمة جاءت لتمسح فكرة اللاجئين وتسكر ملف اللاجئين وتلغيه. مع مرور الوقت صرنا نقول لا. مشان الله الاونروا لا.
سليم تماري: [01:32:40.05]
صحيح.
أحمد البيقاوي: [01:32:40.53]
من غير الاونروا لم يكن الفلسطينيين سيكونون فلسطينيين.
سليم تماري: [01:32:44.52]
مزبوط، ايوه.
أحمد البيقاوي: [01:32:45.45]
أنا لا أفهمها هذه. يعني هذا التحوّل قفزة كبيرة!
سليم تماري: [01:32:48.18]
عندي علاقة تاريخية مع هذا الصراع لانه اشتغلت لفترة طويلة بملفات اللاجئين بالأونروا. يعني من ناحية ارشيفية من ناحية بحثية. الذي صار إنه تعرف الاونروا أسست نتيجة قرار الامم المتحدة الذي جزء منه كان انشاء وكالة الغوث ومعادلة للعودة او التعويض. فكثير ناس كانو يروا الأونروا كطريقة من قبل الغرب والأمم المتحدة لتمتص القضية الفلسطينية عن طريق اعطاء الفلسطينيين تعليم وصحة. وكان في يعني بداخل المخيمات كان في محاربة لإنشاء مثلا بيوت. فيها مفارقة. يعني استقرار الفلسطينيين في المخيمات كأنّه كانت مؤامرة من قبل الغرب وأمريكا تحديدًا. لتذويب القضيّة الفلسطينيّة. فلأجل ذلك بالأول كان لا، المخيمات فقط خيم بعدها الواح الزينكو، بعدها مجيء الطوب صار مؤامرة، لأنه يؤدي إلى أن الناس يستقرون فيها. بعد الـ 67. الناس اكتشفوا أنه إذا ما استقر الواحد في بيته لا يقدر أن يناضل. يعني البؤس.. في تفسير لينيني قديم أنه كلما زاد البؤس كلما زادت شرارة الثورة بين الناس. هذه صابها تحوّل كبير بعد 1967 أنه إذا الواحد بقي يصارع الحياة اليومية لا يقدر أن يُفكر استراتيجيًا بما بعدها. فالاستقرار والاردن أعطت نوعًا من الاستقرار للفلسطينيين بحياتهم اليومية، يجعل الانسان يعطيه بحبوحة ليقدر يناضل سياسيًا. طبعًا إذا زاد البؤس كتير يصير مهووسًا يعني بالاستحواذ على ما يكفي لقوته.
سليم تماري: [01:35:15.34]
وإذا صار في بحبوحة كثير ينسى القضيّة. فالفكرة كانت إنه وكالة الغوث. مؤسسة هامة جدًا للتعبير عن هوية الشتات. وقاعدة هامّة جدًا لتثبيت حقوق الإنسان في العودة. تحوّلت القضية من رؤية وكالة الغوث كمؤامرة لوكالة الغوث كتعزيز للهوية الفلسطينية في الشتات. في المخيمات. في المعسكرات. الى اخره. هذا صار تدريجي بعد 1967. وبعدين، ابتداء من قبل عشرين سنة صار في هجوم ثاني على وكالات الغوث من قبل اوروبا واميركا. انهم يعلّمون الفلسطينيين ويعطونهم يعني مادة ثقافيّة ضد اليهود ضدّ إسرائيل وبالتالي يكفي إنه المخيمات يجب أن تصير عمليًا مساكن عادية، مثلما صار ببقيّة اللاجئين في العالم. وتعبير وكالة الغوث كصيغة لتعزيز الهوية يجب أن نقضي عليه لأنه الآن صار في معاهدة سلام بين منظمة التحرير وإسرائيل، وانتهت القضيّة وبالمناسبة مؤسسة الغوث كتعبير عن هذا الوجدان يجب أن ينتهي فصار في هجوم ثاني على وكالة الغوث ليس من قبل الفلسطينيين من قبل الغرب. وبدأت بمناهج التعليم والخدمات الصحيّة التي تعطيها. وهذه معركة ثانية تبنتها إسرائيل طبعًا بشراسة بحرب الإبادة في غزة، أنه يجب أن نقضي على وكالة الغوث ومشت معها امريكا. والآن صارت وكالة الغوث جزء هام جدًا من التراث الفلسطيني والدفاع عنه.
أحمد البيقاوي: [01:37:13.30]
طب الآن انت تحس انه الموقف الفلسطيني من الاونروا يوازيه تغيّر نظرة الفلسطيني لتعريفه لنفسه وتعريفه للاحتلال أيضًا او فرص التعامل معه.
سليم تماري: [01:37:27.82]
يمكن بشكل ثانوي. يعني الاونروا لعبت دورًا هامًا جدًا في تعليم الفلسطيني اللاجئ في الشتات وداخل الضفة الغربية وبغزة.
أحمد البيقاوي: [01:37:44.38]
هو كان المدخل الأول حتى كان لافت لي أنه المدخل الأول للتعاطي، لقبول الفلسطيني للاونروا مدخل التعليم حتى قبل الصحة.
سليم تماري: [01:37:53.23]
مزبوط، تعليم قبل الصحة وتسجيل اللاجئين كمواطنين فلسطينيين يعني، كان في صبغة قانونية لوجود الأونروا. الآن أصبح الدفاع عن الأونروا هو الدفاع أيضًا عن الهوية الفلسطينية، لم يكن هكذا الوضع أبدًا. وكالة الغوث حقيقةً حتى من ناحية أرشيفية صارت هي المصدر الأساسي لأرشفة الوجود الفلسطيني في الشتات، ويوجد لدينا مادة غنية جدًا جدًا جدًا؛ لأن وكالة الغوث جهاز بيروقراطي ضخم جدًا، وقد حافظ على كل المكونات الإحصائية والأرشيفية للوجود الفلسطيني في الشتات من خلال مادة ديمغرافية، معلومات صحية وتعليمية، ومن ناحية أخرى يجب أن لا ننسى الخرائط والصور لمراحل الشتات الفلسطيني التي صوّرتها الأونروا، أرشيف الأونروا كثير كثير مهم في الدراسة التاريخية لتحولات الشعب الفلسطيني، والآن مركزه الأساسي في وادي السير في الأردن. لكن في غزة كان الأرشيف الصوريّ والفيديو _لا أعرف ماذا حلَّ به الآن، ربّما قد تدمّر_ لحسن الحظ جزء منهم قد حُفظ إلكترونيًا أو على الأثير، فتم الحفاظ على جزء منه، وربما تدمّر بقية هذا التراث، فـ أرشيف الأونروا جدًا هام كجزء مكوّن لرصد التاريخ الفلسطيني.
أحمد البيقاوي: [01:39:49.32]
أشعر أيضًا أن النقاشات المتعلقة بالأونروا بين الناس المعارضين لها والناس الذين يؤيِّدونها تكون جدًا حادة، فيمكن أن تجد رسالة فعليًا أو ورقة بحثية ما تحكي عن خطورة أو مخاطر الأونروا، تمام؟ ويمسك مسار زمني من البداية لحتى اليوم ويذكر مخاطر الأونروا على قضية اللاجئين، وعلى الهوية الفلسطينية بشكل أساسي أو العكس؛ أن يرجع ويمسك المسار الأول للنهاية. أحيانًا أرى أن المسارين أو حتى فكرة انك ترى المسار إيجابي من بدايته لنهايته أو سلبي من بدايته لنهايته ففيه تهميش لموقعنا احنا في المعادلة، وكذلك غير صحي.
سليم تماري: [01:40:31.90]
صحيح غير صحي، لكن يعني في الأساس الحرب ضد الاونروا كان لها مصدرين؛ المصادر الغربية انه لا بد للأنروا أن تكون مرحلة انتقالية في تشغيل وحماية اللاجئين وانتهى دورهم. بالعكس دورهم كان يعني عاكس لإصرار الفلسطينين على حق العودة كتهديد للوجود الاسرائيلي، وبالتالي الأونروا يعني هذا هدف سلبيّ فيها. لكن من وجهة نظر الفلسطينيين، في الواقع كان هناك مخططات بدأتها الاونروا والتي كان أحد ضحاياها مشروع العَلَمي في أريحا؛ مشروع الإنشاء العربي والذي كان رئيسه موسى العلمي والهدف منه كان تشغيل وحماية اللاجئين، كانوا يرونه جزء من مؤامرة الأونروا لتذويب الهوية الفلسطينية عن طريق إدماجها في الوضع الاقتصادي في الارض في أريحا. بعد ذلك تغيّر الوضع، كانوا يرون مشروع موسى العلمي بالعكس؛ كبداية رائدة لإعطاء الفلسطينيين قدرات أن يستقلّوا بأنفسهم عن طريق التعليم المهني والزراعة، لكن كان هناك جانب آخر، كان هنالك مشاريع قد تبنّتها الأونروا لإعادة تأهيل الفلسطينيين خارج فلسطين، من أهمها: مشروع سيناء، والذي هو الآن مشروع اسرائيلي بالمناسبة، حيث يتم تأهيل الفلسطينيين في مناطق بعد العريش، وعلى الساحل في البحر الأحمر في سيناء. ومشروع جونستون لاقتسام مياه غور الأردن سنة 1951-1952 والذي كان مشروعًا أمريكيًا، وكان جزء منه موجّه للأونروا لتشغيله. وذاك المشروع كان الهدف منه إسكان قسم هائل من اللاجئيين الفلسطينيين في غور الأردن. وفي الواقع تم تبنّي جزء منه في عقبة جبر، وعين السلطان، وعبيدات يعني مناطق في غور الأردن كلها وأريحا، وكان هناك وقتها هجوم شرس على الوكالة بسبب ضلوعها بهذه المشاريع، لكنها انتهت بعد الـ 1955 انتهت الأفكار، لكن ظلت هنالك فكرة وهي أن الاونروا هي إحدى أدوات إعادة إسكان الفلسطينيين خارج فلسطين أو داخل فلسطين في تجمعات بشرية تنسيهم حق العودة.
أحمد البيقاوي: [01:43:34.31]
لفتني في واحدة من مقابلات تقارب مع إيهاب محارمة وهو من مخيم عقبة جبر، فكنت حين أسأله نفس السؤال الذي سألتك إياه في البداية؛ ما الحدث أو المشهد الذي غيّر نظرتك لكونك فلسطيني أو عزَّز أو خلق عندك الهوية الفلسطينية، فكان قد حكى لي على مشهد يتعلّق بالطابور الذي تقف عليه من أجل أن تأخذ المساعدات! أنا من ذاك الوقت كلما تُذكر الأونروا في أي سياق، يعني بعيدًا عن كل هذه النقاشات السياسية فأصير أفكر ما الفلسطيني أو ما نفسية الفلسطيني التي تخرج من هذا المكان أو من هذا الموقع أو من هذا المشهد؟ يعني مرة أراه مشهد ضعف أو انكسار، ومرة أراه دافع؛ لأن التخلص من هذا المشهد أو عدم تكراره مرة ثانية، لكن لا أعرف! هل خطر لك هذا المشهد قبل اليوم؟
سليم تماري: [01:44:31.39]
صحيح هذا جانب هام، احنا لم نتكلم عنه، أن الأونروا كانت رمزًا للذل الفلسطيني، يعني الناس واقفين ينتظرون توزيع الطحين مثلًا، الملابس المستعملة، وهذا جانب هام، يعني نفسياً انتهت الأونروا كبوتقة للدعم يعني الكفاف الفلسطيني الذي جعلهم يشعرون ببعضهم لأجل الحصول على الدعم والمساعدات. لكنها في النهاية برهنت أنها إطار تجمُّع ومحافظة على الهوية الفلسطينية وكان كثير مهم، والذي كانت نتيجته ظهور المعسكرات والمخيمات الفلسطينية؛ البوتقة الأساسية في بروز النضال السياسي داخل منظمة التحرير، فكان القاعدة! هل الأونروا لعبت هذا الدور عن وعي؟ لا نعرف. يعني أكيد الذين خطَّطوا للأونروا كانوا يرونها كحل مؤقت لتعبئة فلسطين ضد إمكانية التعبئة السياسية عن طريق إعطائهم مساعدات، فالهدف منها والنتيجة ليست نفس الشيء! وهكذا التاريخ يعني دائمًا يخلق.
أحمد البيقاوي: [01:46:11.22]
بعيدًا عن الاونروا، نحيّدها، ما هو الاثر على اللاجئ حين تقول هذا مشهد الذل مشهد الانكسار كيف ينعكس على اللاجئ بكونه فلسطيني؟ يتحول للعنة؟.
سليم تماري: [01:46:26.28]
الأونروا؟
أحمد البيقاوي: [01:46:27.54]
أحكي الفلسطيني اللاجئ حين يقف على هذا الطابور ويتعرض لهذا الذل، كيف يصير يتعامل مع كونه فلسطيني؟ مع هويته الفلسطينية؟
سليم تماري: [01:46:37.56]
باتجاهين متناقضين؛ الأول انه يصير بده يتخلص من هذا الوضع بأي طريق، وطبعًا بعد الحرب الأهلية في لبنان أحد الطرق الهامة صارت الهجرة خصوصًا الدول الاسكندنافية، وأن الذل الذي تعرض له الفلسطينيون في لبنان خصوصًا، _لكن ليس فقط في لبنان، بل سوريا والأردن_ صار مصدر ضغط للهجرة، والدول الاسكندنافيه في البداية وأيضًا بعدها أمريكا وكثير من الدول الأوروبية وألمانيا منهم، أعطتهم المخرج، لكن في نفس الوقت ميّزت بينهم وبين العرب الآخرين الذين ليسوا في المخيمات، بما فيهم فلسطينيين حصلوا على جنسيات لبنانية، وسورية صاروا جزء من النظام يعني، صار هنالك شرخ اجتماعي طبقي بداخل الفلسطينين والذي كان هذا الذل قد عزّز فيهم كونهم فلسطينيين مستقلين عن العالم العربي بمصيرهم. يعني نتيجة متناقضة من ناحية أصبحوا يريدون أن يهربوا، فتجد كثير فلسطينيين في الآخر _بما فيهم أقارب لي أنا_ الذي لم يعد يعرِّف نفسه فلسطيني! صاروا لبنانيين، أردنيين، لكن الذي حدث _وأنا برأيي الشعلة الأساسية كانت للتحوُّل الكبير بين الاندماجيين الذين هربوا بهويتهم؛ الجيل الثاني والثالث هي الانتفاضه الأولى_ الانتفاضة الأولى أعطت شعلة هامة، وأتصوّر أن حرب الإبادة في غزة ستلعب نفس الدور في المستقبل؛ في تعزيز هوية فلسطينية مناضلة لمستقبل من نوع آخر. الانتفاضة الأولى أعطت الأمل للفلسطينيين بأن الاحتلال غير ممكن أن يدوم، ويوجد طريقة لمقارعته، وليست طريقة تكون بالكفاح المسلح، لأن الكفاح المسلح نخبوي بطبيعته، يعطي الناس بطولة لأناس يطلقون النار، لكن لا يستطيع الكل أن يكون جزء منها، لأن أناس عاديين لا يريدون أن يضحّوا بحياتهم، لكن في نفس الوقت، لا بد أن يكون عندهم كرامة وعزة بموقفهم، فالانتفاضة الأولى لعبت هذا الدور بطريقة هامة جدًا.
أحمد البيقاوي: [01:49:26.08]
في الثمانينات أين كنت؟
سليم تماري: [01:49:28.99]
فلسطين.
أحمد البيقاوي: [01:49:29.65]
أين؟
سليم تماري: [01:49:30.55]
يعني جزء.. أنا طول الوقت في رام الله. كنت أدرس بالخارج، درست فترة ببريطانيا وفي فترة بامريكا.
أحمد البيقاوي: [01:49:41.50]
يعني شهدت على النقاشات الأولى للإسلاميين في فلسطين؟
سليم تماري: [01:49:47.13]
نعم نعم. يعني في الانتفاضة الأولى. التي تمثلت في تشكيل حماس سنة 1988، كان نتيجة الانتفاضة الأولى، ووضع المخيمات وقمعها الداميّ من قبل شارون والحكّام الاسرائيليين في غزة. كانت الشرارة الكبيرة في مخيمات غزة، وفي الضفة الغربية كانت عودة الروح كما يقولون في تلك الفترة، لكن واضح انه احنا طبعًا قادمين من خلفية علمانية يسارية، كنا نرى في التيار الإسلامي محاولة جرّ الوجدان الفلسطيني _لا أريد القول لمستنقع لكن لنوع من السلفية التي نحن في غنى عنها؛ لانها تقضي على النهضة العربية، النهضة السورية، النهضة الفلسطينية باتجاه قريب على توجّهات الإخوان المسلمين. لكنهم برهنوا في النهاية أنهم أصلب وأقدر على المقارعة والمقاومة من اتجاهات العلمانية، ووربما دخلوا في معارك خاسرة لكن واضح أن عودهم كان أصلب.
أحمد البيقاوي: [01:51:23.32]
أنت حكيت عن هذه المرحلة بدأت من الـ1988 لكن هي قبل ذلك. يعني من بدايه الثمانينات. يعني بدايه نقاشات الإسلاميين في فلسطين.
سليم تماري: [01:51:33.40]
لم نكن كثيرًا واعين لها. كان في يعني تصوير كاريكاتوري للإسلاميين من خلال أهداف حزب التحرير واستعادة الخلافة. وكانوا -أتذكر كنت أحضر مهرجانات حزب التحرير- كانوا يلبسون فيها أغطية رأس كأنّها من أفلام هوليوود، أنه هدفنا هو الخلافة.
أحمد البيقاوي: [01:51:56.82]
هذا أين كان الكاريكاتير؟
سليم تماري: [01:51:59.22]
مثلًا ملعب الفرندز كانوا سنويًا حزب التحرير يعملوا مهرجان إحيائي للخلافة، وتقريبًا كانت أشبه بالكرنفال كرنفال ساخر. لكن كان في طبعًا وجود قوي للإخوان المسلمين، لكن بداخل المعارك الطلابية مثلًا في جامعة بيرزيت الإسلاميين بدأوا يأخدون موقع هام جدًا خصوصًا من خلال معارك الحجاب، انه على حين غفلة في بداية الثمانينات صرت ترى نساء محجّبات، لم تكن تراهم أبدًا لا في الهيئة التدريسية ولا حتى بين الطلاب! والناس ينسون أن حرب الـ 1948 أزالت الحجاب عن النساء الفلسطينيات في المهجر، فعلى حين غفلة صرت تراه قليلًا في بداية الخمسينات مع ظهور حزب التحرير. وبعدها في السبعينات مع دخول الإخوان المسلمين لمعترك النضال الفلسطيني. أكيد كانوا موجودين دائمًا، لكن لم يكن لهم وجود مرئي إلا في بداية الثمانينات في ساحة المعارك الطلابية.
أحمد البيقاوي: [01:53:24.15]
وهذا الانقسام الذي حكيته (كنا علمانيين يساريين مقابل الإسلاميين) إذا بدي اسمي هذا الانقسام هو كان سبق تأسيس حماس وجاء نتيجة له؟
سليم تماري: [01:53:38.78]
سبق تأسيس حماس.
أحمد البيقاوي: [01:53:40.01]
سبق تأسيس حماس.
سليم تماري: [01:53:41.45]
تراه مثلا في غزة وهنا نحن ما حكينا عن الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي كان فصيل كثير هام في البروة الثقافية للوعي الفلسطيني بعد 1948 في الداخل خصوصًا من خلال "راكاح" دور راكاح (الحزب الشيوعي الإسرائيلي). وأيضًا في الضفة الغربية وغزة الوجود الفلسطيني الشيوعي كان موجود من قبل 1948 وبرز لأن الدول العربية قمعت كل الحركات السياسية بمجملها إلا التي كانت تابعة لحزبها، يعني حزب البعث خصوصًا بسوريا والعراق، ووجود أقل بقليل للقوميين السوريين، كان هنالك وجود للقوميين السوريين مهم جدًا في فلسطين، هشام شرابي مثلًا كان من قيادات الحزب، كان اليد اليمنى لـ أنطون سعادة في لبنان وكان له دور في تأسيس الحزب القومي السوري بفلسطين. وجنين كانت المركز الأساسي للحزب القومي السوري. لكن في القدس ورام الله وغزة كان هنالك وجود شيوعي قوي لعب دورًا هامًا جدًا في بلورة الثقافة المقاومة بعد 1967 بالنسبة للضفة الغربية وغزة وقبل 1967 في داخل "اسرائيل". هذا الحزب كان المكون الرئيسي للجبهة الوطنية في السبعينات، ولعب دورًا بارزًا جدًا في الملتقى الفكري العربي بالقدس والذي كان رئيسه ابراهيم الدّقاق وكان نقيب المهندسين، وأنا كنت عضو نشيط في الملتقى الفكري العربي في تلك الفترة. بعد ذلك برزت الفصائل الأخرى، فكان الصراع بين اليسار الذي جمع بين الحزب الشيوعي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية من جهة، وبين حماس وفتح من ناحية ثانية. بالأول فتح بعدها حماس دخلت في الصورة. فبالتالي ما البوتقة التي عكست هذه الصراعات؟ هي المجلس الطلابي في الجامعات الفلسطينية التي كانت المنصة الرئيسية للنضالات السياسية الفصائلية. ووقتها وأنا أتحدث الآن عن بداية الثمانينات، بدأنا نرى بروز التيار الإسلامي كفصيل مهم جدًا في الساحة الفلسطينية، لكن دائمًا كان الصراع الأساسي بين فتح واليسار، وبعدها دخل الإسلاميون للحلبة وصاروا جزء هام، الآن صاروا ربما لا أعرف تمامًا إذا في جامعة بيرزيت أكثر من النصف صاروا تقريبًا، وجامعة النجاح قمعوهم أكثر من بيرزيت، بيت لحم، وفي غزة صار هنالك تكوين فصائلي للجامعات نفسها، صار في جامعات تابعة لحماس وجامعات تابعة لفتح، وجامعات يعني فيهم كوكتيل من هذه المؤسسات.
أحمد البيقاوي: [01:57:01.35]
طب هذا كيف انعكس فعليًا هذا الانقسام الحادّ بين علماني وإسلامي؟ كيف كان ينعكس على الهوية الجامعة؟
سليم تماري: [01:57:09.15]
لازم أعترف لك انه جامعة بيرزيت مثال جيد جدًا في البداية كان لتعايش هذه التيارات، والتعايش فكري سياسي، وأيضًا يعني معادلة مريحة جدًا بالتمثيل الفصائلي الذي كان فيها صراعات ودِّية _يمكننا أن نسمِّيها_ وأظن أن سبب الصراعات الودِّية هي انه ولا أي فصيل استطاع أن يهيمن كليًا، فكان في كما تقول نضال قد أغنى الحركة الطلابية والحركة السياسية بمضمون ثقافي هام جدًا والذي كان برأيي أنا نموذج للتعايش المستقبلي في التمثيل السياسي بداخل البرلمان الفلسطيني والدولة نفسها، أي أنه تتشكّل من كل هذه التيارات بشكل تمثيلي لغاية ما صارت الواقعة في غزة، وبعد ذلك في الضفة الغربية بين حماس وفتح بشكل دمويّ والذي أوصلنا للمرحلة البائسة التي نعيش فيها الآن.
أحمد البيقاوي: [01:58:27.85]
لكن اذا بدك تأخذ جامعة بيرزيت فهي نموذج ربما لأن موقعها قرية بيرزيت بحد ذاتها ووجودها بالوسط، اذا بدنا نحكي يعني في سياق الضفة الغربية هذه عوامل أيضًا ساعدت أن تخلق هذا النموذج الذي تحتفي فيه اليوم؟ يعني أقصد هنا في تنوع كان يتجاوز الحديث فقط عن إسلاميين وعلمانيين ويساريين، وهذا ربما الذي ساهم أكثر في حالة التلاحم أو النموذج الذي انت تحكي عنه ونحتفي فيه؛ حالة التنوع والتفاهم الموجود بينهم؟
سليم تماري: [01:59:08.90]
نعم لأن طبيعة الصراع في الجامعات كان بشكل حاد، لأنه قسم كبير من الشعب الفلسطيني لا هو هنا ولا هناك، يعني قسم كبير كان ربما يمكنك أن تسمّيه محافظ، لكن لا يتساوق أبدًا مع التيار الايديولوجي الإخوانجي، ولا الجهاد الإسلامي. لكن كان يعني يرى انه بتمثيله لازم يكون في نوع من الاندماج الفكري بين التيار الإسلامي والتيار الوطني العلماني. وهذه اللعبة التي كان ياسر عرفات شاطر كثير في أدلجتها، انه من ناحية احنا مجتمع اسلامي، ومن ناحية ثانية احنا مجتمع متنوع لازم ينعكس هذا التنوع في إبراز هويتنا الثقافية. وفاة عرفات كانت طبعًا تؤدي إلى بروز قيادات جديدة من أهمها قيادات أبو مازن الغير قادر على أن يعالج هذه القضية، لأنه يرى عدوّه في التيار الإسلامي، وأن هذه معركة فصائلية لا بد أن تنحسم لصالحهم، لانه هم كيف يرون القضية؟ انه حماس غير قادرة على أن تكون جزء من دولة فلسطينية مستقلة؛ لأنه هدفها التحرير الشامل، وبالتالي هذه تورطّنا في معارك مع "اسرائيل" ومع الغرب والتي نحن في غنى عنها. مع انه في الواقع حركة حماس _وربما الجهاد الإسلامي لا أعرف_ وصلوا لنفس القناعات التي وصلت لها فتح بعد مؤتمر أوسلو انه هذه الكعكة يجب أن تقتسم. لكن التعنُّت في مقاومة التيار الإسلامي بهذا الشكل الحاد أدّى أن يحدث هنالك إقصاء والذي أدى بدوره لوقوع السلطة الفلسطينية في فخ التعامل مع "إسرائيل" بشكل سياسي وأمني مدمِّر جدًا لقدرة الكيان الفلسطيني انه يقدر يتعامل بطريقة مستقلة مع وضعه.
أحمد البيقاوي: [02:01:51.96]
وأنت بأي سنين أعدت النظر بموقفك؟ يعني كنت تقول في الأوّل كان عندك نظرة نقديّة للإسلاميين أو يعني هكذا، بعدها مع الوقت تغيّر موقفك؟!
سليم تماري: [02:02:06.39]
لا ما تغير موقفي أنا يعني كنت نشيط في مؤسسة الدراسات كباحث وكانت علاقتي قوية جدًا مع سميح حمودة والذي كان يمثل تيار إسلامي قوي جدًا _يقولون انه كان مع الجهاد الإسلامي؛ لانهم هم الذين تبنّوا تأبينه، لكن أنا لا أعرف_ فكانت علاقتي به قوية جدًا، وكنا نصدر مجلة اسمها حوليات القدس مع بعضنا، فكنت أجد فيه مرونة كبيرة من جهة، وصلابة فكرية من جهة أخرى، والتي كنت يعني لا أقبلها فكريًا لكن قبلتها كنوع من العاكس لتيارات ثقافية لا بد أن تتعايش مع بعضها وإلا فإنها تقضي علينا فلسطين، فلا أعرف هل نسميها نقطة تحول! هي كانت أشبه بوعي بأن التيار الإسلامي ليس اقصائيًا بقدر ما أن التيار العلماني كان إقصائي للتيار الإسلامي، وياسر عرفات بذكائه الكيدي _دعونا نقول_ وصل لطريقة للتعامل مع التيار بطريقه تآمرية من ناحية، لكنها استطاعت أن تحافظ على هذا النوع من التعايش الذي نحن اليوم غير قادرين عليه!
أحمد البيقاوي: [02:03:46.05]
إذا تقدر تتخيل: لو لم يتم تأسيس حماس -كيف عملنا في أول الحوار- لو لم تحدث النكبة. لو لم يكن هنالك حماس؟
سليم تماري: [02:03:58.08]
يعني حماس كانت قانعة بصفتها جزء مكوَّن من الإخوان المسلمين انه تلعب دور توعوي، والذي هو دائمًا كان موقف حزب التحرير بالمناسبة، انه حزب التحرير ليس هدفه الوصول للسلطة، طبعًا هدفهم الخلافة الإسلامية، لكن إنشاء وعي والإخوان المسلمين سيد قطب كان هذا مركزه. ويعني التحوّل الذي صار بالإخوان المسلمين في مصر؛ محاولة الاستيلاء على السلطة والذي تخيّله عبد الناصر كمؤامرة. وربما كانت مؤامرة مدبرة من النظام، انه يقضي على الإخوان المسلمين، وتأثيرهم. كان هدفه توعوي انه احنا في عصر الجاهلية الجديدة ويجب أن نصل إلى أفئدة المثقفين والمفكرين، بحيث انه نقضي على الجاهلية الجديدة لصالح صحوة إسلامية تعيد نموذج السلف الصالح. هذه تغيرت كليًا يعني وصلوا لقناعات بعد الانتفاضة الأولى انه التوعية هذه ما بتزبط، يعني ربما هنالك أناس صاروا يصومون ويصلّون أكثر، لكن في النهاية لا بدّ أن نلعب لعبة سياسية. وهذه أدخلتنا في صراعات مع التيار الإسلامي اللذي في مصر، وطبعًا بدأ من زمان أيام يعني الصراع مع حسن البنا وسيد قطب، لكن في فلسطين بسبب التوليفة المختلفة كليًا في فلسطين التي فجّرتها الانتفاضة الأولى، وكون حماس صارت جزء مكوِّن سياسي هدفه تقاسم الكعكة مع منظمة التحرير أو الدخول والسيطرة على منظمة التحرير.
أحمد البيقاوي: [02:06:03.86]
اوك عين حماس في مراحل التأسيس او بمسارها كانت أكثر للإخوان المسلمين او جزء من الأمّة الإسلاميّة أكثر من كونها فلسطينية؟ أم دائمًا كانت عينها داخل فلسطين ضمن حركات التحرر الوطنية؟
سليم تماري: [02:06:20.86]
أظن انه أصبح هنالك فلسطنة لتوجهات حركة الإخوان المسلمين بفلسطين في مرحلة مبكرة. لانه واضح انه.. أنا بتذكر كثير من الخطب الرئيسية التي كانوا يعني مناصري الجهاد وحماس في الحركة الطلابية كانوا يدعون لنوع من التواصل مع الأمة الإسلامية، وانه الحركة القومية العربية هي بمثابة عدوتنا. وانه فلسطين لن تصحّ إلا بصفتها جزء من الوقف الإسلامي والعالم الإسلامي. هذا الحكي كان ينحكى بصراحة وقوة، بعد ذلك صارت جزء مكوّن من الحركة الفلسطينية، يعني هي وجدت أنها لا تقدر على أن تستحوذ على أفئدة الناس اذا ظلت حركة يعني أبعادها باكستان والهند وأندونيسيا، واذا لم تكن جزء مكوّن من الثقافة العربية في العالم العربي، ومن فلسطين كجزء من الفصائل المقاتلة لتحرير فلسطين. وليس ضم فلسطين إلى الأمة الإسلامية _وأنا ما بعرف حقيقةً ولست متأكد متى صار هذا التحول بنظرهم، وربما كان نوع من التكتيك لا أعرف_ لكن واضح أن الأغلبية العظمى من قيادات حماس وفي غزة خصوصًا وصلت لقناعة انه احنا جزء من الحركة القومية الحركة الوطنية أقصد لا أريد القول القومية ليست القومية أكيد بل الحركة الوطنية والتي هدفها تحرير فلسطين، وفي التسعينات ربما وصلوا لقناعة انه الزّهار مثلًا وإسماعيل هنية كانوا يقولونها صراحةً، وقبلهم الزعيم الحمساوي في قطر، مشعل، مشعل أول واحد كان والذي وصل لنوع من التوليفة؛ نحن مستعدون أن ندخل في هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل" لصالح توليد دولة فلسطينية مستقلة على أرض حزيران، هذه قالوها بصراحة، وصارت حماس جزء من الصراع الفئوي داخل فلسطين بهذا الهدف.
أحمد البيقاوي: [02:09:13.25]
تعرف نحن هنا لا نُسجّل في البيت، نُسجل يعني بمكان ثاني، لكن كنت أحب لو سجلنا في البيت، الآن يخطر لي، لو حضرت على البيت وسجلنا، كنت ستلاقي تطريز ومخدات تطريز ومفتاح عودة على الباب وخارطة فلسطين هنا، وخارطة فلسطين خلفي، ماذا كان يأتيك انطباع عني لو جئت وشفت هذه الرموز في البيت كلها؟
سليم تماري: [02:09:39.50]
أراك كأحد مصادر هوس الشتات.
أحمد البيقاوي: [02:09:44.66]
ههههه
سليم تماري: [02:09:45.08]
المهم جدًا في تاريخنا طبعًا. يعني نحن كنا قليلًا نسخر عليكم.
أحمد البيقاوي: [02:09:52.07]
اسخر عليّ، تفضّل:
سليم تماري: [02:09:53.27]
انّه هؤلاء الذين يعيشون في عالم التطريز.
أحمد البيقاوي: [02:09:56.87]
متى بدأتم السخرية علينا؟
سليم تماري: [02:09:59.18]
أنا دخلت في هذه المعركة من البداية بصراعي مع.. لأنني كنت أنا من مؤسسي جمعية الفولكلور الفلسطيني في جمعية إنعاش الأسرة وأصدرنا _أنا كنت رئيس تحرير مجلة تراث المجتمع العدد الأول_ وكنت في تلك الفترة كسوسيولوجي أرى التراث الفلسطيني له بعدان؛ بعد نهضوي: الهدف منه تعزيز الهوية الفلسطينية، لكن جانب نقدي للتراث الذي دعنا نسمّيه رؤية علمية أن التراث مليء بالتناقضات ولا بد أن نعرِّضه لمجرحة الجرّاح؛ أن نأخذ الصالح ونرمي الطالح منه، وفي تلك الفترة كان في تيارين كثير متصارعين في معالجة هذا التراث الفلسطيني والذي شعاراته كانت التطريز ومفتاح العودة وإلى آخره لصالح رؤية أكثر نقدية كانت، أن التراث لا بد أن يتعرض للنقد، كما عمل المفكر السوري في أزمة الهوية بعد النكبة بعد احتلال 1967 صادق جلال العظم. انه لازم نعرِّض المجتمع الفلسطيني لنفس نوع النقد الذي عرضه الفيلسوف السوري صادق جلال العظم للمجتمع الفلسطيني، فأنا أضحك يعني أقول كنا قد استهزءنا لكن يوجد هذا النوع النقدي الذي برأيي لا بد أن يكون جزء من رؤيتنا لصالح يعني مشروع نهضوي فلسطيني، لا يرتكز فقط على الجانب الخطابي ورقصات الدبكة والتراث كرمز جامد للهوية الفلسطينية.
أحمد البيقاوي: [02:12:10.32]
يعني أنت عندك مشكلة مع البطيخة بدل العلم (الفلسطيني)؟
سليم تماري: [02:12:16.53]
مشكلة البطيخة..
أحمد البيقاوي: [02:12:17.55]
عندك مشكلة مع البطيخة؟
سليم تماري: [02:12:19.44]
عندي مشكلة مع البطيخة.
أحمد البيقاوي: [02:12:20.07]
ما هي مشكلتك مع البطيخة؟
سليم تماري: [02:12:21.81]
يعني فيها ابتذال أرى مرات. هي بالعكس يعني طريقة مبدعة جدًا في التحدي. لكن فيها ابتذال إنه بتعرف تلك الفترة كان في نوع من الإملال في استعمال الدبكة والغناء الشعبي لتعزيز الهوية. من ناحية كان يُجيّش العقل الفلسطيني. من ناحية ثانية يجعلنا جزء من الخلفية الفولكلورية التي عفى عليها الزمن.
أحمد البيقاوي: [02:13:04.14]
هكذا تراها؟
سليم تماري: [02:13:06.40]
أرى هذا التناقض فيها.
أحمد البيقاوي: [02:13:09.58]
أنا لأنه أيضًا خلال حديثك انه مثلا يعني أشعر أن هذه الرموز لفترة طويلة كان عندي مشكلة معها، وأنا ما عرفت حنظلة داخل البلد يعني! شو حنظلة يعني؟! ميدالية بالانتفاضة الثانية عملوه لماذا يعني أنا بدي أحمل ميدالية لفلسطين وأنا في طولكرم يعني حاملها؟! لكن في الخارج صارت هذه الرموز موجودة والناس أصبحت توصّيني عليها، وبعدها فعلياً أنا ما بعرف كيف صرت أنا أحب هذه التطريزات، يعني صار في اشي هيك بدخل، أعتقد له علاقة بدعم المشاريع الريادية، والمشاريع التي تشتغل على تحديث وتطوير وتطريز وكذا، في اشي سياق بزنس يعني هون أكثر، لكن أيضًا من مكان ثانٍ صرت أرى خاصة في الإبادة انه طوال الوقت تعريفنا للرمزيات الفلسطينية أو شكل النضال الفلسطيني هو الشيء المكلف، فالناس فعليًا في الأوقات التي يكون فيها تضحية كبيرة تروح باتجاه رمزيات ما فيها كلفة، انتبهت للحديث عن البطيخة في الإبادة عندما يقولون انه حتى كيف نقدمها وانه هذا شخص ذكي جدًا في جامعة فرنسية عرف انه اذا قام برفع علم فلسطين كذا فسيُنال منه، فهو راح اختار البطيخة وها هو قد أحضر بطيخة ويقطِّعها وواقف فيها على الباب، واحنا في حالة من الاحتفاء يعني. التناقض الذي انت تقول عنه حقيقي وأنا أراه ولأجل هذا صدّرت لك بيتي، يعني ما أعفيت نفسي.
سليم تماري: [02:14:32.96]
هو بالمناسبة، صراع أقدم؛ لأن فرقة رضا بمصر لعبوا هذا الدور المتناقض في إحياء التراث الشعبي المصري عن طريق الرقص المحدِّث للفلكلور الذي مثَّله درويش، سيّد درويش. يعني عالجوه بطريقة مبدعة محدثة، وصار عندنا نفس النضال احنا فرقة الرقص الشعبي مثلًا بفلسطين، حاولت أن تأخذ القوالب التقليدية للرقص، ودخَّلت عليها أشكال الناس يعتبرونها بدع دخيلة، منها مثلًا أن الشابات والشباب يرقصوا مع بعض، ومنها تحوير لصيغة الموسيقى الشعبية الفلسطينية، وليس فقط بالصوت واللباس وأيضًا بالصيغة. فهذه المعارك دخّلوا فيها كثير وكان في معارضة شديدة جدًا من ضمنها في جمعية الفولكلور التي أنا كنت جزء منها. انه هل الفولكلور حفاظ على التراث أم دراسته النقدية بهدف تطويره. واذا لم يتطور بيصير جزء من شيء أشبه بخلفية بائتة، وكان مفيد جدًا برأيي أنا ولعب دور في تحويل وتحوير الثقافة الفلسطينية بطريقة نقدية، والتي جزء منها كان المعارض الفنية التي تحدث الآن وجزء منها المعرض الفلسطيني من أعلى في اسطنبول.
أحمد البيقاوي: [02:16:28.04]
تحس جانب من نقاشات التطريز تحديدًا أنه يعكس حالة استقطاب بين فلاحين ومدن؟
سليم تماري: [02:16:35.69]
هكذا كنت أفكّر.
أحمد البيقاوي: [02:16:37.55]
وما زلت؟
سليم تماري: [02:16:40.10]
إنّه..
أحمد البيقاوي: [02:16:41.18]
قصدي من الرمزيات...
سليم تماري: [02:16:42.26]
تعرف أغنية وديع الصافي. "خذ ليلى بنت الضيعة".
أحمد البيقاوي: [02:16:45.29]
اه كويّسة ليلى..
سليم تماري: [02:16:47.03]
وسلمى الشريرة بنت المدينة التي تغوي الشباب. نفس الشيء عندنا. يعني في عندنا تراث تقليدي. ببعث الهويّة الفلسطينيّة. كان في بالبداية إنّه الفلاح يمثل روح الفلسطيني، والمدني هو الدخيل الذي يمثّل التراث الغربي. وهذه معركة قديمة بالعالم العربي أيضًا. بمصر خصوصًا ولبنان وسوريا، إنّه المدني يُشكّل البوتقة التي أدخلت الفكر الاستعماري علينا، وبعث الفلاح هي استعادة للروح الاصلية التي سيّد درويش حاول يدخلها بالموسيقى. لكن واضح إنه بدراستنا للتراث. يجب أن نهتم بالتراث المدني، والتوليفة اللي جاءت بالنهضة الغربيّة إلى بلادنا، جزء من تراثنا هي، يعني البحث عن النقاوة الفكرية في التراث برأيي طريق مسدود. يعني رمزيًا يلعب دور. واليسار كان يتبنّى دائمًا الفلاح خصوصًا عن طريق تبنيه للفكرة الماوية، أنّ الريف يحاصر المدينة.
سليم تماري: [02:18:21.79]
في مفكّر صيني مشهور اسمه "لين بياو" كان يرى أنّ الثورة الصينيّة انتصرت بسبب محاصرة الفلاح للمدينة. وهذه لعبت دور مثير ومخرّب بالثورة الثقافية لماو تسي تونج، والقيادات الاربع له، أنه يجب أن نعود إلى روح القرية بعيدًا عن تخاذل وفساد المدينة. وهذه يعني فكرة سياسيًا أصبحت متطرّفة، قضت تقريبًا على الثورة الصينية. وكان كثير من المثقفين الفلسطينيين بما فيهم أنا، نتبناها كبوتقة لبعث الروح الفلسطيني عن طريق تبني الفلاح وتراثه، وما زالت جزء من مكونات الفكر الفلسطيني المعاصر. ويعني برأيي يجب أن نتجاوزها.
أحمد البيقاوي: [02:19:27.04]
وبقدر آخذ كل الذي تحكيه على كل الثقافة والأدب والحديث عن التراث. إنّه في مبالغة بأهميّته ودوره في الحديث أو في معركتنا مع الاحتلال.
سليم تماري: [02:19:41.89]
اه طبعًا يعني دور ايديولوجي، إنه بالاحتلال. إنه مثلا خلال الانتفاضة، فكرة العودة للأرض، اقتصاد الكفاف. انه اعتمادنا على السوق الاسرائيليه في العمل والبضائع الاسرائيليّة في الاستهلاك أدّت إلى أسرلتنا. وبالتالي تدميرنا كقضيّة. يعني كانت رؤية اقتصادية ثورية في تلك الفترة، لكن أبعاد العمليّة محدودة جدًا لأن إحياء الأرض يجب أن يأخذ شكلًا رمزيًا، ليس بالضرورة أنّه عودة للفلاحة، العودة للفلاحة تقريبًا مستحيلة كحل لقضيّة الاقتصاد الفلسطيني اليوم.
أحمد البيقاوي: [02:20:40.64]
نحن نُسجّل اليوم بظرف استثنائي الآن، يعني غير أننا في اسطنبول لكن يوم أمس رجعت الإبادة على غزة من جديد.
سليم تماري: [02:20:49.37]
صحيح.
أحمد البيقاوي: [02:20:50.21]
وكأنّه -لا أعرف إذا كنّا مُخدّرين الفترة الماضية أو تخدّرنا مرّة ثانية- يعني حتى الواحد فقد الحسّ بالتواصل مع هذا الحدث.
سليم تماري: [02:20:59.00]
ايوة.
أحمد البيقاوي: [02:20:59.42]
قبل قليل أنت تحدثت أنّ هذا حدث على المدى الطويل سيكون مهمًا جدًا في تعزيز الهوية الفلسطينية او في تعزيز الفلسطيني لنفسه. لكن سأرجع هكذا قبل أن أدخل بتفاصيل الإبادة. أسألك على أثر هذه الإبادة عليك أنت شخصيًا. يعني من بدايتها. ماذا أثّرت فيك؟ كيف غيّرت نظرتك لنفسك؟ على مستوى شخصي، على مستوى عام؟
سليم تماري: [02:21:29.69]
مبكر كثير نحكي عن هذا الموضوع لأننا نحن الآن في خضم الضربة التي نعاني منها نتيجة حرب الإبادة في غزة، والناس تقريبًا وصلوا للحضيض في يعني.. يمكن حضيض كلمة قويّة. لكن تمامًا مثلما صار بحرب حزيران أنّ النّاس شعروا بضرب الهزيمة، وبعدها صاروا يبحثوا عن تجاوز هذه الأزمة عن طريق تصوير الفكر، نحن الآن لا أريد أن أقول في الحضيض. لكن ما نزال بصدد ضربة، في صدى ضربة نعاني منها نتيجة حرب الإبادة. ونرى تكالب كل الأنظمة في العالم ضدّنا. ليس فقط الأمريكان والإسرائيليين، التحالف غير المقدس، والذي معظم الدول الاوروبيّة دخلت فيه مع اسرائيل في هذه الحرب والحرب الثقافية التي تصير ضد فلسطين بالعالم الغربي، وتقاعس لا نريد أن نقول تكالب. لكن تقاعس العالم العربي في مواجهة هذا الوضع الجديد عن طريق وجود حروب اهلية في كل العالم العربي تقريبًا تقضي عليه، على قدرته على المواجهة هذه فيها بذور التجاوز، صعب كثير أحكي عنها لأنه لا أعرف انا.
أحمد البيقاوي: [02:23:16.79]
لا أريد أن تحكي في سياق عام، أقصد تحكي أنت سليم في بيتك في يومياتك في أشياء في نمط حياتك، كل حدا تأثر يعني في اشي في حياتك فقدت طعمه، لم تعد تعرف تتواصل ومش عارف تميزه، ولم تعد تقدِّره، ولم يعد يعني لك، هذا الحدث على سليم على مستوى كثير خاص بتقدر تستحضر اشي اليوم مدرك انه هو تغير عندك مع مرور سنة ونص؟
سليم تماري: [02:23:49.74]
ممكن لازم أسالك انت هذا السؤال، لانه كما تعرف حين تكون في بؤرة العاصفة لا تكون قادر أن ترى آفاق التغيير التي تحدث فيك،لكن واضح انه يلزمنا نوع من القوة التي تساعدنا على الوقوف على أقدامنا مرة ثانية لمواجهة المستقبل، وأنا برأيي الميدان الثقافي لدينا الدعم الفكري والنفسي الذي يمكنه أن يساعدنا على الصمود والمقاومة مرة ثانية. أمس كنت أسمع الموسيقى التي تم عرضها بمناسبة هذا المهرجان، تعطيك روح هائلة على التفكير بطريقة هادئة حتى تتجاوز الأزمة، وهذه أهمية الفن، الموسيقى والتصوير. طبعًا نحن كمثقفين ما عندنا قدرات أخرى غير عن الثقافة، لكن الثقافة تلعب دور هام جدًا في الحفاظ على النفس والمقاومة والتي لعبته مرات ومرات عديدة في 1948، 1956، 1967 انتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، والذي حافظ على بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه من ناحية وفي قدرته على تجاوز الأزمات التي نواجهها. لكن أنت تسألني سؤال صعب جدًا؛ لانه أنا الآن..
أحمد البيقاوي: [02:25:39.47]
طبعًا صعب.
سليم تماري: [02:25:40.34]
غير قادر أن أتخيّل.
أحمد البيقاوي: [02:25:41.69]
ثقيل ثقيل. ثقيل.
سليم تماري: [02:25:43.68]
يعني إذا تريد منّي نظرة تفاؤلية، غير موجود.
أحمد البيقاوي: [02:25:50.37]
لا ما في نظرة تفاؤلية، ليس بالضرورة. هو بالآخر يعني لون الأيام هذه رمادي يعني مثل لون الدمار الذي دعني أقول طغى على كثير أشياء وتفاصيل، ويلفتني فعليًا كل أحد ثمّة شيء قد تغير. بتعرف على مستوى الشباب في حدا بقول أنا لم أعد أريد الإنجاب، أو حدا بقول لم أعد أريد أن أتزوج، أو لم أعد أريد أن أظل في الخارج أو بدي أرجع على البلد جوا، فكل واحد فعليًا هكذا عنده نظرة مختلفة.
سليم تماري: [02:26:15.36]
لكن خليل السكاكيني كان عنده شعار بعد الحرب: تعالوا لننقرض تعالوا ننقرض. لكن أنا الآن يعني وصلت لسنٍّ كبيرة إنه أملي جيلك أنت وجيل اسماء والزملاء هنا، هم الذين سيحملون الشعلة.
أحمد البيقاوي: [02:26:38.16]
اجيالنا احنا كيف والأجيال اللي بعدنا. كيف راح تشوف حدث اليوم بتعريف نفسها كفلسطينية؟
سليم تماري: [02:26:49.84]
سؤال مهم جدا. يعني جيل أبي وأمي. كان جيل الهزيمة وجيلنا بفترة كان جيل المقاومة. ونحن الآن نتطلع لجيل آخر يتجاوز النكبة الثانية التي دخل فيها الفلسطينيون بعد حرب الإبادة بغزة. يمكن كل جيل يرمي العلم على الآخر كي يطلع بمستقبل أحسن.
سليم تماري: [02:27:33.22]
مش هيك؟!
أحمد البيقاوي: [02:27:34.27]
هو كل جيل يطلع يسأل الجيل الأكبر انه انتم لماذا أورثتمونا هزائم؟ بعد ذلك نمر بمرحلة.. أنا أتذكر هذا العنفوان كان بوقت غزو العراق. بعدين جاءت 2011 كيّفنا، رجعنا تعنترنا مرّة ثانية (اعتزازًا بموجات الثورات) يعني لأنه حين كنا بغزو العراق نسأل جدودنا. يعني أسأل سيدي: ماذا سيحدث؟ فيقول لي لن يصير شيء، كذا، فأنا بالعنفوان الذي عندي، أقول له: لا. يعني أنتم أورثتمونا الهزائم فلا يجب أن يكون لك قولة يعني، بعد ذلك تحس حدث ورا حدث حدث ورا حدث بتكسر. لكن أنت اطلعت عليه بشكل ايجابي، أنا غير قادر يعني غير قادر أن أراه. غير قادر أن أتحسسه.
سليم تماري: [02:28:11.03]
ايوة.
أحمد البيقاوي: [02:28:11.48]
بقراءة تاريخيه في أحداث كبيرة وثقيلة مررنا فيها. كنت ترى الشيء السلبي والايجابي فيها. على مستوى التكوين الفلسطيني، تعريف الفلسطيني لنفسه اليوم.
سليم تماري: [02:28:21.62]
اها.
أحمد البيقاوي: [02:28:25.07]
ترى أنّ هناك شيئًا ايجابيًا بهذه المساحة؟
سليم تماري: [02:28:30.08]
نحن الآن في اسطنبول. تتذكر قبل 15 سنة صار في تيار تبنّاه النظام التركي (العثمانية الجديدة) أردوغان كان جزء منه. لكن نسيت من هو الرئيس التركي الثاني الذي كان مع اردوغان. ما هو اسمه؟
أحمد البيقاوي: [02:28:51.67]
عبد الله غول. عبد الله غول.
سليم تماري: [02:28:55.12]
غول.. آه .. لا غول لا في واحد ثاني غير عبد الله غول. لكن غول واحد منهم كان. انشأوا النهضة في اطار تقريبًا تركي قومي؛ عودة امجاد الدولة العثمانية وأنا واحد من الناس أتصور في كتير ناس آمنوا إنه يمكن القوميّة العربيّة استنفدت قدراتها، ويجب أن تكون جزء من نظام أوسع موازي لاوروبا، وهي العثمانية الجديدة. لكن للأسف سارت بطريق قومي تركي، ويعني كان في مجلة يطلعها رضوان السيد/ لبنان. اسمها "الاجتهاد" حملت لواء العثمانية الجديدة، ورؤية نقدية للتاريخ العربي في الفترة العثمانية. وأنا برأيي الآن سيبرز تيارات جديدة، وجزء منها سيكون عروبيًا، وجزء منها سيكون إسلاميًا. وجزء يمكن يكون في إطار شرق اوسطي مبني على الفكرة العثمانيّة التي كانت دولة متعددة القوميات لكن تُمثّل روح مشرقية أو شرق أوسطيّة، وعن طريق الاقتصاد المشترك تواجه العالم خصوصًا على ضوء يعني التراجع الامريكي الحالي عن طريق قيادات ترامب. فواضح نحن الآن على فترق طرق ونبحث عن تيارات فكرية جديدة تساعدنا بمواجهة...
أحمد البيقاوي: [02:30:56.43]
على مستوى أقرب، ويمكن مع توقيت الحلقة هذه في شعور اليوم أنّ ابن غزة هو غزاوي أكثر من كونه فلسطيني، في مظلوميّة اليوم صارت موجودة. يمكن بمرحلة كيف ابناء الـ48 كانوا ما قبل الانتفاضة الثانية، حين اشتُغل على استحضار رموز عربيّة من كل مكان؛ جمال عبد الناصر والشيخ امام وكذا كي يشعر الواحد أنه انت جزء من كل فلسطيني وكل عربي. اليوم في حدث كسر هذه النقاط التي يمكن من اول الحوار كنا نحكي عنها أو نرى ايجابياتها، كيف تُجمّع وتعزز هذه الهوية الفلسطينيّة الجامعة. دعني أقول وصار حالى الإبادة التي رجّعت أبناء الـ 1948 مئة سنة للوراء، وراحوا أكثر.. الآن نرى شيء أقرب للأسرلة، لكن يمكن نتردد في تعريفه كأسرلة يعني.
سليم تماري: [02:31:42.39]
اه في اسرلة اكيد. الذي تحكي عنه انت دائمًا كان موجودًا. انظر، ببداية القرن كانت الهويّة محليّة جدًا وهذه لها معالمها؛ أنّ الواحد يعرّف حاله أنّه لداوي يافاوي غزاوي. وفي صراع داخل غزة، بين اللاجئين وأهل البلد دائمًا كانت موجودة هذه، وبرزت بعد هزيمة 1948 ودائمًا مع الهزائم ترجع وتتعزز. ترى الناس بالنهاية انّ الوعي الاقليمي محدود جدًا من ناحية قدراته على التعبئة السياسية من ناحية ثانية على أفقه. لأجل ذلك الأفق العروبي كان دائمًا تجاوز ليس للوطنيّة الفلسطينيّة، تجاوز للوجدان الاقليمي المحلي.
سليم تماري: [02:32:40.69]
الذي تحكيه كثير صحيح، أنّ الهزيمة دائمًا تؤدّي للناس أن يرجعوا لقوقعة الرؤيّة المحليّة، ومرّات العائلية العشائرية تقوى. ويمكن الطائفيه أيضًا. لكن بفلسطين لحسن الحظ تجاوزنا المرحلة الطائفيّة التي غزت لبنان وسوريا، لأنّه يمكن الطوائف الدينيّة صغيرة جدًا وليس لها مقوّمات البقاء لحسن الحظ في فلسطين. لكن إنه هذا الوجدان المحلي دائمًا يبرز في زمن الهزائم، ودائمًا في محاولات لتجاوزه عن طريق هويات أخرى. بلبنان، ليس فقط في لبنان، بالدول العربيّة الأخرى كان دائمًا في قوة للهويات المخضرمة الفينيقية الفرعونية الاشورية. وفلسطين يعني دائمًا لها باع في هذا المجال، يعني أتذكر في بداية السلطة الفلسطينيّة كان في محاولات إحياء للكنعانيّة. أننا نحن الكنعانيون. لماذا؟ لأنهم قبل اليهود كانوا موجودين، لكن المكوِّن الكنعاني بفلسطين مقابل المكوِّن الفينيقي بلبنان ضعيف كثير، لأن الناس بالنهاية الثّقافة العربيّة سائدة عندهم.
أحمد البيقاوي: [02:34:24.73]
الآن، واضح يعني أيضًا مع مظلوميّة الإبادة، وكيف نحكي؟ إنه في مظلوميّة صارت بمكان ما، ممكن لفترة إنه الغزاوي يشعر أو أبناء غزة يشعرون بأنه في مظلوميّة خاصّة فيهم، تفرّقهم عن البقيّة، ويرى حاله أكثر من فلسطيني. ابن الـ 48 نفس الشيء، ابن الضفة نفس الشيء. لكن الآن بهذا الوقت نحن نُسجّل 2025. نظرتك أنت سليم تماري للشعب الفلسطيني، ما تزال تراه شعب فلسطيني مع كل هذا المسار الكبير. أم أيضًا تفتح سؤال أو شعوب فلسطينيّة ضمن إنّه انشغل على تفريقها وتشتيتها وتفكيك هويتها وإلغاء كل هويّة جامعة لها وإحداث دائمًا مظلوميّات محليّة صغيرة تجعل الناس تتقوقع في محلها.
سليم تماري: [02:35:11.21]
اه.
أحمد البيقاوي: [02:35:11.57]
أم ترى الفلسطينيين كشعب فلسطيني كامل يعني، أو مجموعة من الشعوب؟
سليم تماري: [02:35:19.67]
انا أرى تيّارات متصارعة. يعني لا تنسى انّ محاولات تعزيز كيانات اقليمية فوق الفلسطينية وتحت الفلسطينية دائمًا كانت جزء من المخطط الصهيوني. انا لا أعني أنها مكوّنات صهيونيّة لكن كان الإسرائيليون دائمًا يحاولون الاستفادة منها. مثلا سنة 1926 او 1927 الحركة الصهيونيّة تبنّت شيء اسمه "حزب الزُّرّاع" خصوصًا في منطقه الشمال، في منطقة الجليل الادنى ونابلس جنين. حزب الزراع أسموه، وعملوا بنك كان يعطي قروض للمزارعين كي يقارعوا الملاكين الكبار. وكان فعلًا محاولة صهيونيّة لخلق هوية ريفية مستقلة انعكست لاحقًا بسنه الـ1998 بإنشاء "روابط القرى". وروابط القرى تعتمد على هذه الناس من الناحية الاقليمية التي حكيت عنها، بجبل الخليل خصوصًا كان في عشيرة الجعبري تلعب دورًا هامًا في فصل الهويّة الفلسطينيّة عن مقوّمات القوميّة. بالدرجة الأولى كانت تتساوق مع العودة الهاشمية لفلسطين للضّفة الغربيّة، و"إسرائيل" استفادت كثير من هذه الصراعات، تبنّت الجعبري تبنّت كذلك "روابط القرى". لكن فشلت لأن منظمة التحرير كان عندها القوّة الايديولوجيّة والقوّة اللي تجاوزت هذه. هل هذه النزعات الفئويّة الاقليميّة سترجع وتنهض؟ جزء منها سيقوى لأنّ الناس حمايةّ لكيانهم يلجأون للعائلة، للعشيرة، للمنطقة. يعني دائمًا في هذه النعرة الاقليميّة التي تقوى وقت التجزئة. لكن بالنهاية سيدركون أنّ في التجزئة ضعف، ولا يمكن تجاوزها إلا عن طريق روابط ذات طابع وطني على مستوى الاقليم. يجمع بين غزة والضفة، ويجمع بين مناطق الشتات الفلسطيني وتجمعاته. ممكن تتّجه بالمناسبة، إسلاميًا للأمّة الإسلاميّة فوق فلسطين، أو عروبيًا باتجاه إحياء فكرة وحدة بلاد الشام والقومية السوريّة، لا أعرف يعني بأيّ اتجاه، لكن هذه الصراعات موجودة، بيننا. وثقافيًا برأيي تغني التكوين الفلسطيني بكل أشكاله المختلفة، يعني ليس كلّها جانب سلبي بأبعادها الثقافية.
أحمد البيقاوي: [02:38:34.82]
نحن في "تقارب" نعطي مساحة مفتوحة بالآخر. نترك لك المايكروفون من غير أسئلة. إذا أردت أن تحكي أي شيء. تكلّمنا طويلًا.
سليم تماري: [02:38:42.98]
بكفي تعبنا,
أحمد البيقاوي: [02:38:43.34]
كثير اسئلة. اه تعبنا كثيرًا. يسلمو ايديك ويعطيك ألف عافية.
سليم تماري: [02:38:48.98]
شكرًا.
أحمد البيقاوي: [02:38:49.73]
سأعطيك المايك. إذا أردت أن تحكي أيّ شيء؛ تؤكّد على أيّ شيء تنفي أيّ شيء. تفضل.
سليم تماري: [02:38:57.41]
شكرًا جزيلًا. شكرًا على الاستضافة. وأحييك وأحيي برنامجك المثير. بتأمل أن أبدأ بمشاهدته في المستقبل.
أحمد البيقاوي: [02:39:11.21]
شكرًا جزيلا لك. ويعطيك الف عافية. شكرًا.
سليم تماري: [02:39:14.57]
أهلًا.
أحمد البيقاوي: [02:39:14.90]
يعطيك العافية.